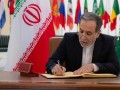الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
طريق إلى الشمس
طريق إلى الشمس

بقلم - محمد سلماوي
لجريدة «المصرى اليوم» في نفسى مكانة خاصة، ليس فقط لأننى عاصرتها منذ بداية إنشائها، ولكن أيضا لأننى عرفتها من مختلف جوانبها، حيث تعددت وتنوعت علاقتى بها، من كاتب زاوية أسبوعية ساخرة إلى كاتب عمود يومى، ومن رئيس مجلس التحرير بها إلى مؤسس ورئيس مجلس أمنائها، لكنى كنت قبل ذلك كله وبعده قارئها اليومى المثابر أياً ما كان موقعى بها.
ومازلت أذكر منذ أكثر من ١٥ عاماً يوم عرض علىّ الصديق العزيز صلاح دياب أنه يفكر في إصدار جريدة فشجعته على ذلك قائلاً له إن السوق الصحفية تتطلع إلى نوعية جديدة من الصحافة بعد أن بدأ القراء يسأمون من الصحافة القومية الرتيبة التي لم تتطور منذ عشرات السنوات، فإذا نجحت الجريدة التي تريد إصدارها في تقديم صحافة جديدة مغايرة فإن أمامها الآفاق مفتوحة واسعة لتحقيق نجاح كبير ربما نافست به الصحف القومية الراسخة.
كان معنا يومها الزميل الكبير والصديق العزيز صلاح منتصر، وكان رأى صلاح مختلفاً، فقد كان يرى أن إصدار جريدة مستقلة في ظل الأوضاع الصحفية والسياسية التي كانت قائمة آنذاك هو مغامرة محفوفة بالمخاطر، وأنها لابد ستجلب على صاحبها من المتاعب ما هو الآن في منأى منه، فالجريدة الجديدة لكى تكون ناجحة يجب أن تتعرض للقضايا الحقيقية التي تشغل بال الناس، وللمشاكل التي يعانون منها، وهذا سيضع الجريدة بالضرورة في مواجهة مع السلطة، والسلطة ستجد في المشروعات الاقتصادية لصلاح دياب ما يمكنها من الضغط عليه أو إصابته بالضرر حتى تقلم أظافر جريدته أو تسكتها.
كان اللقاء في منزل صلاح دياب بمنيل شيحا، تلك الناحية التي لم يكن أحد قبله قد فكر في أن يسكنها، وسط بيوت الفلاحين وغيطان الزراعة الممتدة على النيل، فقلت له: لقد استطعت ��روح المغامرة التي تسكنك أن تَخَلَّق من هذا المكان موقعاً فريداً لا يملك مثله أحد، فبينما زحف بقية الناس مثل القطعان إلى الصحراء ليسكنوا المنتجعات الجديدة التي أقيمت هناك، والتى لا يختلف أحدها عن الآخر، مشيت أنت في الطريق المعاكس وفزت عليهم جميعا بهذا المشهد الفريد الذي يحيط بنا الآن على نيل مصر الخالد ووسط الخضرة الغناء، وبهذه الروح أنا واثق أن مشروعك الصحفى سيجد لنفسه هو الآخر مكاناً فريداً وسط الصحف القائمة الآن.
والحقيقة أن ما قلناه أنا وصلاح منتصر في ذلك اليوم قد تحقق بالفعل رغم ما بدا يومها من تعارض صارخ بين الرأيين، فقد تمكنت «المصرى اليوم» بالفعل من أن تقتنص لنفسها مكاناً فريداً وسط بقية الصحف المصرية، وهو المكان الذي مازالت تحتله حتى الآن، مما جلب على صاحبها من المتاعب ما أضر ضرراً بالغاً بأعماله ووصل به إلى حد الاعتقال.
لقد استطاعت «المصرى اليوم» على مدى ١٥ عاماً من أن تنحت لنفسها مكاناً في نفس القارئ جعله لا يستغنى عنها سواء في ظل حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو في خضم الثورة وما أعقبها من تقلبات، أو في ظل حكم الإخوان، أو بعد أن استقرت الأوضاع في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، فطوال تلك الفترات المختلفة الواحدة عن الأخرى، كانت «المصرى اليوم» هي المعبر الحقيقى عن نبض الشارع المصرى، وقد شاهدت أبناء الشعب الذين نزلوا إلى ميدان التحرير أثناء ثورة يناير وهم يحملون لافتات لصقوا عليها الصفحة الأولى من «المصرى اليوم»، لأنهم وجدوا فيها أفضل تعبير عما يريدون الهتاف به والمطالبة بتحقيقه. وقد ظهرت بعد «المصرى اليوم» صحف أخرى مستقلة والحقيقة أن بعضها تفوق صحفياً على «المصرى اليوم» لكن تلك الأخيرة ظل لها مكانها الخاص في نفس القارئ لأنها عبّرت عنه في كل الأزمات التي مرت على البلاد، ومازالت تعبر عنه بأفضل من أي من الصحف المستقلة الأخرى، لذلك لم يدانيها أحد منها في توزيعها، أي في إقبال القارئ عليها.
ومن خلال معايشتى لـ«المصرى اليوم» على مدى السنوات الماضية، أستطيع أن أؤكد أن قاعدة الانطلاق التي انطلق منها هذا النجاح، هو ما تنبهت إليه الجريدة قبل أن تطالب به الثورة، وهو إفساح المجال لجيل جديد من الشباب ليعبر عن رؤية جديدة لبلاده وليتعامل بشكل مختلف مع معطياتها، وذلك بعد أن تكلّس الفكر القديم طوال العقود السابقة في قوالب جامدة يصعب كسرها، لكن «المصرى اليوم» كسرتها بكتائب الشباب العاملين بها، وبقياداتها التي كانت هي الأخرى من الشباب، وباستعداد مالكها للسير وراء قوة الدفع الذاتى التي ولدتها قوة الشباب داخل الجريدة، مطالباً فقط بأن تظل الجريدة ليبرالية الاتجاه تسمح بالتعبير عن جميع الأفكار دون مصادرة، وقد تضافرت كل تلك العوامل فشكلت منظومة جديدة فتحت طريقاً جديداً وسط الغابة الصحفية التي كانت أشجارها الكثيفة قد سدت منافذ الشمس.. نعم لقد فتحت «المصرى اليوم» الطريق واسعاً ومنيراً لتعبر منه آمال وآلام الجماهير إلى ضوء الشمس، طوال ١٥ عاماً، ووسط جميع الظروف، وتحت جميع الأنظمة.
المصدر :جريدة المصرى اليوم
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
GMT 01:05 2024 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير
حكاية الحكومات في فلسطين... والرئيسGMT 02:47 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير
لماذا مدح بوتين بايدن؟GMT 01:26 2024 الإثنين ,19 شباط / فبراير
سياسة في يوم عيد الحبGMT 01:23 2024 الإثنين ,19 شباط / فبراير
كوارث التواصل الاجتماعي!GMT 02:27 2024 الأربعاء ,14 شباط / فبراير
تستكثرُ علي بيتك؟بعد أن أصبح الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين تراجعه ناجم عن جني أرباح من المستثمرين
لندن - ماريّا طبراني
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا يوم الأربعاء، بلغت 3300 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار أمريكي للأونصة، مع استمرار بحث المستث...المزيدصابرين تكشف أسرار رحلتها الفنية من الغناء إلى التمثيل وتأثير الكبار في تشكيل ملامح مشوارها
القاهرة - العرب اليوم
خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير ضمن سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد "شمّ النسيم"، فتحت الفنانة صابرين قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مشوارها الفني، وتجاربها الإنسانية، وندمها الوحيد، وت...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©