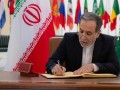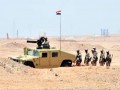الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
التعليم وضرورة سد الفجوة المعرفية بيننا والعالم
التعليم وضرورة سد الفجوة المعرفية بيننا والعالم

بقلم - عمار علي حسن
تنجم الفجوة أو الفراغ المعرفى عن تفاوت شديد فى مستوى المعارف والمعلومات بين الطبقات الاجتماعية فى المجتمع الواحد، امتدادًا إلى ما بين الدول نفسها من تباين فى هذا المجال. ويمكن هنا الاعتماد على التعريف الإجرائى الذى أقرته الأمم المتحدة لقياس الفجوة المعرفية، وهو يقوم على معايير سبعة هى: التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم التقنى، والتدريب المهنى، والتعليم العالى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحال الاقتصاد، والبحث والتطوير، والابتكار، والبيئة الاجتماعية، وهى معايير تجمع بين تحصيل المعلومات والمهارات، وبين التمويل وما يمنحه من إمكانيات.
ويبدو أن التعليم هو السبب الأكبر فى نظر أغلب الناظرين إلى هذا الأمر، فتباينه وتباين المهارات الاتصالية بين الطبقات يؤديان إلى هذه المشكلة، فالنشاط الاتصالى يتجه دومًا نحو الطبقات الأعلى لأن مُكنتها المالية تجعلها قادرة على فعل هذا. وهناك أيضًا تباين فى المعلومات المخزنة أو الخلفية المعرفية، ووجود التعرض الانتقائى، حيث يقصد منتجو المعرفة توجيهها إلى أناس بأعينهم، والضّنّ بها على آخرين.
وفى ركاب هذا صار هناك حديث مسهب عن «الفجوة الرقمية»، التى تعنى الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية فى النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة، والقدرة على استغلالها، وهى تحمل فى ثناياها فجوات عدة، تقنية ومعرفية واتصالية، تتفاوت فيها الدول، بين متقدمة ونامية، وهى ليست مسألة قدَرية أو حتمية أو أبدية، لكن الدول التى لا تحوز إمكانيات كبيرة فى هذا المجال تجد صدًّا وردًّا، حين ترغب فى تغيير وضعها إلى الأفضل، من الدول المتقدمة تكنولوجيًّا، فى إطار صراع الأمم.
ويمكن هنا القول إن «الفجوة الرقمية» تعود إلى أسباب تقنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، وتتوزع على نطاقات متتابعة، عالمية وإقليمية ومحلية، ويختلف فى تقدير معناها كثيرون، كل حسب اختصاصه، الذى يحدد الزاوية التى ينظر منها إليها، فالسياسيون يرونها ذريعة للتدخل فى شؤون الدول، والاقتصاديون يرونها حالة من التخلف عن اقتصاد المعرفة، والتربويون يتعاملون معها على أنها مسألة تتعلق بالتعليم بدرجة أساسية، والإداريون يعتبرونها أمرًا عارضًا سيزول تدريجيًّا مع زيادة معدل التطور التقنى، والاتصاليون يفهمونها على أنها نقص فى شبكات الاتصال، ووسائل النفاذ إليها، بما يؤدى إلى قلة السعة الكافية لتبادل مختلف رسائل المعلومات، والاجتماعيون يقدرون أنها انعكاس لعدم المساواة على أساس النوع والطبقة والعمر ومستوى التعليم ومكان السكن، والفلاسفة يرونها مسألة أخلاقية ترتبط بغياب العدل، وينقسم معتنقو الأفكار السياسية الكبرى حولها، فيراها بعضهم وجهًا كريهًا للنزعة الاستعمارية، ويربطها مناهضو العولمة باحتكار الدول المتقدمة للمعلومات، ثم تعمد عدم وصولها إلى الدول النامية والفقيرة، فيما يراها آخرون تعبيرًا عن سيادة الرأسمالية وانتصارها، وهناك مَن يصفونها بأنها وجه لانتهاك حقوق الإنسان لأنها تحرم كثيرين من حق الوصول إلى المعلومات.
وتوجد زاوية أخرى للفراغ المعرفى، تصنعها البحوث الميدانية النمطية المجردة، التى تجمع معلومات وتحللها كميًّا فى عمليات مكرورة لا تؤدى إلى شىء ذى بال، وتلك التى تمارس نوعًا من الخداع المنهجى، فتراعى معيارًا اجتماعيًّا متحيزًا، أو تسقط فى التلفيق، ولا تضيف شيئًا إلى المعرفة، ولا تخرج أهدافها عن سعى وراء الترقى المهنى، وحيازة مكانة اجتماعية زائفة، وحرص على نَيْل قبول سلطة سياسية، وانتصار لأيديولوجيا أو اعتقاد دينى أو مذهبى أو حزب سياسى أو جماعية محلية ضيقة، عشيرة أو قبيلة أو طائفة، بل تتخذ من هذا إطارًا مرجعيًّا، ظاهرًا أو خفيًّا، بدلًا من الاتكاء على المرجعيات والنظريات الراسخة فى العلوم الإنسانية ومناهج البحث فيها. هذا ما وقر فى ذهن عدنان الأمين بعد دراسة ميدانية، انتهى فيها إلى القول:
«البحث التربوى تحديدًا يجرى فى بلداننا طبقًا لتقاليد أو طقوس اجتماعية على حساب التقاليد المعرفية، الأمر الذى يُفضى إلى منتج فارغ معرفيًّا تتركز وظيفته فى خدمة منتجِهِ».
ومع تراكم المعلومات وانتشارها وتعقدها يزيد الفراغ المعرفى، وتتفاقم خطورته، إذ إن من شأنه أن يعمق الهوة بين الدول، ولاسيما مع تصاعد دور اقتصاديات المعرفة، والصناعات الإبداعية، فى صناعة التنمية والرفاه، ولا سبيل لتفادى هذا أو علاج ضرره سوى بتعليم حقيقى.
إن التعليم هو أداة المجتمع الناجعة واللينة والطيعة لخلق أفراد أسوياء، قادرين على تحقيق الأمن للمجتمع بمعناه العميق والشامل، وتمثيل ثقافته، والمحافظة عليها وتطويرها، وذلك بما يمتلكه التعليم من آليات تمد النشء بالقدرة على الإبداع، والابتكار، والحوار، والتخطيط للمستقبل، وشغل أوقات الفراغ، والتعايش، والتسامح، وقبول الآخر، وتحمل المسؤولية، وتوافر الالتزام بالواجب حيال الجماعة، إلى جانب أنه وسيلة لرفد برامج التنمية بأشخاص مؤهلين لتنفيذها، والنهوض بها.
لهذا فإن رفَعْنا شعار «التعليم أولًا» ونحن نخطط لمستقبل بلادنا، فيكون ما فعلناه ليست فيه مبالغة ولا مجازفة ولا انحراف عن المطلوب، ولا تجاوز فى ترتيب سُلَّم الأولويات. ومَن يؤمنون بأن المداميك الأولى فى أى بناء لمجتمع عصرى هى التعليم، لديهم كل الحق فيما يعتقدونه، ودومًا لديهم ما يستشهدون به ليبرهنوا على صواب رؤيتهم، فلا يأتى حصيف منهم على ذكر قضية التعليم إلا ويروى على مسامعنا عدة وقائع أو تجارب، ممتدة عبر الزمن والحضارات والثقافات والظروف، تؤكد، بما لا مجال لشك فيه، أنه لا أمل فى تقدم أو نهضة، بينما مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ترزح تحت نير مناهج تعليمية متخلفة، يلقنها للدارسين معلمون لم يُحصِّلوا من العلم والمعرفة إلا النزر اليسير، الذى يستعملونه فى كسب أقواتهم، وترقى درجاتهم الوظيفية، متخففين مما فى عنق المعلم من رسالة سامية، ومثل هذا لا يسد أبدًا الفجوة المعرفية بيننا وبين العالم.
GMT 08:40 2025 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
جانب فخامة الرئيسGMT 06:34 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
المصريون والأحزابGMT 04:32 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
رسائل الرياضGMT 04:28 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
د. جلال السعيد أيقونة مصريةGMT 04:22 2025 السبت ,05 إبريل / نيسان
إيران وترمب... حوار أم تصعيد؟بعد سبع مرات من التثبيت المركزي المصري يبدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير للفائدة
القاهرة ـ العرب اليوم
خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام ...المزيدسلاف فواخرجي ترد على شائعة زواجها من بشار الأسد وتواجه الإقصاء الفني بسبب مواقفها السياسية
دمشق - العرب اليوم
نفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي شائعة زواجها من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي انتشرت مؤخراً على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول وثيقة تزعم ارتباطها به رسميّاً.وكتبت فواخرجي عبر حسابها ال...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©