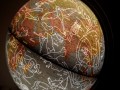الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
صين الشرق الأوسط مرة أخرى
صين الشرق الأوسط مرة أخرى

بقلم - عبد المنعم سعيد
مرة أخرى فإننا لا نتحدث عن الصين وإنما عن مصر، الأولى هنا هي مرجعية ومثال ونموذج لدولة خرجت أخيرا من الكمون إلى الساحة العالمية قوة عظمى تكون علامة بالفعل على إشهار واقع عالمى جديد. القصة الصينية العالمية لم تكن شائعة إلا في روايات الفقر والفاقة والفشل رغم الشعارات الفاقعة، والكتاب الأحمر، والكتب التي كانت تغرق معارض الكتب السنوية المصرية مجانا تقريبا للحديث عن أمجاد لا وجود لها في مواجهة أنواع مختلفة من «الإمبريالية» كانت في الحقيقة براقة ولامعه بالغنى والابتكار والإبداع. وربما انكشف الغطاء عن «المملكة الوسطى» و«المدينة المحرمة» عندما وصل الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون إلى الصين ومعه وزير خارجيته هنرى كيسنجر. سجل هذا الأخير في مذكراته أنه عندما دخل ماو تسى تونج إلى حجرة الاجتماع، بدا أن مركز العالم يتغير إلى حيث يوجد ذلك الرجل. لم تكن الصين وقتها أكثر من سلة فقر هائلة، أدت سياسات زراعية فاشلة إلى وفاة ٣٠ مليون صينى نتيجة نقص الغذاء.
ولكن التغيير ما لبث أن أصاب الصين، فلم تمضِ سنوات قليلة على وفاة ماو، حتى دخلت الدولة الصينية في أكبر عملية تنمية عرفها تاريخ العالم، بدءًا من عام ١٩٧٨. وبات ممكناً للصين أن تستعيد هونج كونج وماكاو، وبقى بينها وبين تايوان البحث عن طريقة لكى يكون هناك صين واحدة مع نظامين، كما حدث في الحالتين السابقتين. تغيرت الصين كثيرا خلال العقود التالية، ورغم أن الصين نظرت إلى العولمة نظرة متشككة في أهدافها الغربية الاستعمارية، فإنها سرعان ما وجدت فيها خلاصا صينيا، حيث باتت الدولة الأولى في العالم من خلال التجارة في صادرات تكاد تغطى كافة احتياجات الكون. كان مفتاح ذلك كله هو قدره هائلة على عمل لا ينضب عزمه ودوافعه، ومحصلة من النمو الاقتصادى لا يقل أبدا عن ٨٪ سنويا، وقدرة فائقة على استيعاب تكنولوجيات جديدة جاءت لها من عالم أتى لكى يستغل رخص عمالتها وسوقها الكبيرة، ثم توليدها بصبغة صينية خالصة وصافية.
في مقال الأسبوع الماضى «صين الشرق الأوسط» ذكرت أن وضع ٨٪ معدلا للنمو كهدف استراتيجى لمصر ينهى الحديث عن حجم مشاركة القطاعات الإنتاجية المختلفة من قطاع عام وخاص والجيش الوطنى في الوصول لهذا الهدف. فالحقيقة الساطعة هي أننا نحتاج من هؤلاء جميعا مضاعفة جهودهم وبذل المزيد من العرق والمال والعقل في تحقيق هذا الهدف. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أقرر فيها مثل هذه الحاجة، لكن ما دفع لها هذه المرة هو اشتداد الضغط الفكرى والسياسى والإعلامى، وحتى داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، على دور القوات المسلحة المصرية في تنمية مصر. وقبل أسبوعين زارنى في مكتبى في «المصرى اليوم»، سفير إحدى الدول الغربية، للتعرف والحديث عن مصر والمنطقة والعالم. وبمهارة السفير والدبلوماسية قال لى هل توجد ضرورة لإسناد مشروع إصلاح حديقة الحيوانات في القاهرة إلى الجيش لكى يقوم بها؟.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع من قبيل سفير أو مراسل صحفى أجنبى، وكان الغمز واللمز فيها هو التأكيد على ما يشاع عن هيمنة العسكريين على الاقتصاد من أكبر المشروعات إلى أصغرها. وكما حدث في كل المقابلات السابقة كانت إجابتى على الوجه التالى: أولا أن الهدف من هذا المشروع هو أن ينتهى في أسرع فترة ممكنة، وبأعلى قدر من الكفاءة والانضباط، في حديقة وحيدة وتاريخية في العاصمة المصرية. وثانيا أن هناك حاجة إلى معرفة أن الجيش المصرى هو جيش من المجندين، لا يعرف لا مرتزقة، ولا ضباطه من أصحاب الدماء الزرقاء، وأن الشائع في مصر أنه في كل أسرة مصرية يوجد جندى أو ضابط أو كلاهما معا. مثالى الشخصى هو أننى كنت رقيبا في القوات المسلحة بينما كان أخى الأكبر- رحمه الله- لواء، وشارك كلانا في حرب أكتوبر. وثالثا أن الجيش المصرى وهو جزء من الشعب المصرى، وبقدر ما يقوم بمهمته في حماية البلاد وأمنها، فإن مصر كلها تحتاج قدراته ومشاركته في الإسراع بعملية التنمية التي كان أبرز أمثلتها القدرة على إنشاء قناة السويس الجديدة خلال عام واحد بانضباط وقدرة تكنولوجية وعلمية فائقة. كثير من ذلك يجرى الآن في مصر كلها، والمعجزة التي تحدث في الصحراء الغربية لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء خير مثال على ذلك.
بغض النظر عن الصمت الذي حل على السفير الغربى وهو المعتاد عند ترديد مثل هذا الحوار فإن الفكرة الأساسية سوف تبقى وهى أن مصر في حاجة ماسة ليس فقط الوصول إلى الهدف ٨٪، وإنما تحقيق ما هو أكثر من ذلك. هنا يكون الجهد المضاعف مطلوبا، ولعل «وثيقة ملكية الدولة» قدمت الأساس الفكرى لتخصيص واجبات التنمية بين القطاعات العامة والخاصة في الدولة. ولكن تقسيم العمل، وتوزيع الواجبات، ليس هو المطلب الوحيد المساهم في تحقيق هدف النمو، فضلا عن أن تحقيق ذلك حتى الآن يسير بسرعات بطيئة، وعندما خرجت مشاريعه الأولى لم يكن فيها ما يفتح شهية المستثمرين لا في الداخل ولا في الخارج. المثل الصينى يعطى كثيرا من الدروس حول أن تحقيق القفزات الكبرى لا تحدث إلا بتوافق كافة القطاعات وتوفير المناخ اللازم لها، وفى الظروف المصرية فإن توفير جهاز إدارى أكثر كفاءة وقدرة على توزيع المهام التنموية المختلفة نوعيا وجغرافيا يصبح مهمة وطنية من الطراز الأول. الانتصار الصينى الأعظم لم يحدث فقط «بتخريج» مليار من البشر من الفقر، وإنما الأهم من ذلك كان توسيع الطبقة الوسطى الصينية بمئات الملايين حيث تكون هي مخزن المهارة والقدرة الاقتصادية من خلال توسيع القاعدة العامة للملكية والطاقة الرأسمالية.
من المعلوم أن الفقراء في الصين نسبتهم الآن ١٠٪ أي حوالى ١٤٠ مليون نسمة (الولايات المتحدة بها ١٨٪ فقراء) أي أن ما فوق ذلك يزيد على مليار نسمة من الذين يمتلكون الثروة التي تبدأ من أسهم الشركات إلى محل الإقامة إلى إنشاء المشروعات، وابتكار السلع، وترويج الخدمات وقدرات التسويق والتصدير. مصر الآن لديها ثروات هائلة ليست فقط تحت الأرض من نفط أو غاز أو ذهب، وإنما أصول قوية في مدن واستثمارات أراض زراعية، ومجمعات صناعية وخدمية، جميعها تتطلب جهودا وعملا مكانه القطاع الخاص المصرى. البحيرات التي جرى إعادة الحياة لها مرة أخرى فيها فرص استثمارية طائلة سواء كانت ذات طبيعة عقارية أو إنتاجية، وكذلك الحال في الجزر النهرية والبحرية التي تنتظر بعث الحياة فيها بالبشر المنتجين والمستهلكين، والعقول التي تجعلها مزارات سياحية وخدمية دائمة. تحقيق معدل نمو ٨٪ سنويا ليس حلما صعب التحقيق، وإنما هو واقع ممكن الإنجاز. أن تكون مصر صين الشرق الأوسط في متناول اليد.
GMT 13:05 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
حزب الله بخيرGMT 11:57 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مرحلة دفاع «الدويلة اللبنانيّة» عن «دولة حزب الله»GMT 11:55 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
هل هذا كل ما يملكه حزب الله ؟؟؟!GMT 20:31 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
عشر سنوات على الكيان الحوثي - الإيراني في اليمنGMT 20:13 2024 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
صدمات انتخابيةالمخاوف من عدم إستقرار قيمة الدولار تتزايد بسبب سياسة ترامب الإقتصادية
واشنطن - ماريّا طبراني
مشهد هبوط وصعود قيمة العملات النقدية العالمية أمر إعتيادي في الأسواق ، لكن ما حصل من تراجع لسعر صرف الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة كان غير عادي على الإطلاق . إذ كان سعر صرف الدولار في صعود أثناء الخ...المزيدإيمان الطوخي تتصدر محركات البحث بعد أنباء عن اختفائها 28 عامًا واعتزالها الفن
القاهرة ـ العرب اليوم
تصدرت الفنانة المصرية إيمان الطوخي محركات البحث في مصر خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار أنباء عن اختفائها طيلة 28 عاما، واعتزالها الفن بسبب زواجها من شخصية مصرية رفيعة المستوى. فقد راجت الأخبار حول هجرة الم�...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©