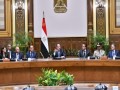الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الشرق الأوسط الجديد
الشرق الأوسط الجديد

بقلم - عبد المنعم سعيد
النتيجة الأساسية لكل سمات الواقع المشار إليه كانت الحاجة لأشكال من التعاون الإقليمي بغض النظر عن النزاعات والصراعات والصدامات السابقة
لوقت طويل كان مفهوم «الشرق الأوسط» غامضاً وموحشاً ومذنباً في المنطقة العربية؛ وكانت التهمة الأساسية له أن صكه والتأكيد عليه في المحافل الدولية ما هو إلا مؤامرة أحياناً أو غطاء أكاديمي على ما سماه الصديقان علي الدين هلال وجميل مطر في كتابهم العمدة «النظام الإقليمي العربي». كان هناك اعتقاد دائم أن هناك ما يكفي من الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين العرب ما يشكل لهم هوية خاصة؛ وما عدا ذلك جاء في المفردات العربية كما سميتها في كتاب سابق لي «دول الجوار الجغرافي» وكان المعني بها إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا. ولكن الحقيقة عالمياً كانت لها صفات استراتيجية حددتها الدول العظمى في المرحلة الاستعمارية حسب المسافة من أوروبا قلب العالم. وهكذا بات الشرق «الأوسط» واقعاً بين الشرق الأقصى الآسيوي والشرق الأدنى الذي يقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. واستناداً إلى هذا الوصف جرت الحرب العالمية الأولى لكي يتغير المفهوم وفق اعتبارات جغرافية واستراتيجية جديدة في الحرب العالمية الثانية حينما أنشأت بريطانيا ما سمته «مركز إمداد الشرق الأوسط» أو «ميسك» لكي يحقق التعاون بين دول المنطقة من أجل التغلب على مصاعب الواردات من أوروبا بسبب حرب الغواصات في البحر المتوسط. ورغم أن بريطانيا شجعت إنشاء جامعة الدول العربية فإنها في ذات الوقت أسهمت بقوة فيما صار «أزمة» أو «صراع» الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل. وبهذا الاسم بات الإقليم معروفاً في المحافل الدولية وفي المقدمة منها الأمم المتحدة، ولكنه ظل دائماً قابلاً للامتداد إلى آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، والإضافة إلى «شمال أفريقيا» أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف الخاصة بالإقليم خلال التسعينات من القرن الماضي. ظهور الإسلامي السياسي وما واكبه من حركات إرهابية وسعت كثيراً من نطاق المنطقة حتى بلغت شرق آسيا والصحراوات الأفريقية. وما بين هذه التعريفات كلها فإن الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية مضافاً لها كل من إيران وتركيا وإسرائيل ظلت المضمون الشائع في وزارات الخارجية للدول المختلفة وبدرجة أقل من الإحكام في الخرائط العسكرية للدول الكبرى.
إضافة «الجديد» إلى اسم الإقليم تكررت إعلامياً وأكاديمياً عبر العقود المختلفة، وفي أعقاب أحداث كبرى، ولكن أكثرها شهرة هو ما وضعه شيمون بيريز على كتاب له بعنوان «الشرق الأوسط الجديد» إبان ازدهار «عملية السلام» بشقيها من المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، والمفاوضات متعددة الأطراف، حيث جرى التبشير بالنموذج الأوروبي في التكامل لكي يحتذى من أطراف الصراع في الشرق الأوسط. ولم يمض وقت طويل على نهاية القرن العشرين حتى غرق الإقليم في دوامات الأصولية الإسلامية، ونوبات «الربيع العربي» وما تلاهما من اضطراب وخلل وحروب أهلية. والآن كتب «مارك لينش» مقالاً هاماً في دورية الشؤون الخارجية تحت عنوان «نهاية الشرق الأوسط: كيف تشوه الخرائط القديمة الواقع الجديد»، واستند في ذلك إلى أن الإقليم بات متلاحماً ومتورطاً مع أقاليم أخرى منها القرن الأفريقي وأفريقيا بشكل عام وكذلك مع إقليم المحيط الهندي وآسيا في العموم. ولكن «الواقع الجديد» بقدر ما وسع من علاقات الشرق الأوسط بالأقاليم المجاورة؛ فإنه في ذات الوقت ظل يعبر عن انعكاسات هذا الواقع على المنطقة وتفاعلاتها والتي تأثرت بالحقائق التي تراكمت مع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وأول ما فيه كان رد فعل «الدولة» الشرق أوسطية لنوبات العنف الداخلي والتدخلات الخارجية والتي رتبت اتجاهات إصلاحية عميقة خلقت احتياجات جديدة متعلقة بالتعاون الإقليمي، وتنمية المصالح المشتركة سواء تعلقت بالغاز والنفط، أو بالحاجة إلى توسيع سوق السلع والبضائع، أو مواجهة الإرهاب. وثانيها أن الأثمان الفادحة للصراع الإقليمي فرضت سلسلة من الحوارات والمباحثات التي خففت من ناحية من توترات «الحالة القطرية»، وفتحت أبواباً للحوار مع إيران وتركيا، أما إسرائيل فقد فتحت العلاقات معها أبواب ما عرف بالسلام الإبراهيمي، وتدفئة السلام مع مصر والأردن بعد عقود من البرودة، وجرى ذلك ضمن إطار منتدى شرق المتوسط، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات القيادية كان آخرها في النقب خرج منها مجموعات العمل الست الجديدة وكان فيها مجموعة واحدة فقط تتعلق بقضايا الدفاع الإقليمي ومواجهة إيران؛ والخمسة الآخرون هم الطاقة، والسياحة، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي والمائي. وثالثها وربما أهمها على الإطلاق كان الخروج الأميركي من المنطقة وما أذن به من عمليات معقدة لمراجعة نتائج انتهاء الحرب الباردة من قبل الصين وروسيا فيما ترتب عليه من حرب أوكرانية ذهبت بنتائجها إلى «الشرق الأوسط» في مجالات الطاقة والغذاء.
النتيجة الأساسية لكل سمات الواقع المشار إليه كانت الحاجة لأشكال من التعاون الإقليمي بغض النظر عن النزاعات والصراعات والصدامات السابقة. بات واضحاً أن الإقليم بات في أمس الحالة إلى الاعتماد على ذاته والدفاع عن مصالحه المباشرة، وهو ما تجلى في تقارب رد فعل دول الإقليم تجاه الأزمة الأوكرانية والذي كان بقدر رفض الغزو الروسي لأوكرانيا، رافضاً للعقوبات الغربية على روسيا، وفاتحاً لقنوات واسعة مع روسيا والصين؛ فضلاً عن تحقيق وقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن وليبيا. هذا التوجه ليس جديداً كلية على المنطقة فقد بشر به الرئيس السادات في النصف الثاني من عقد السبعينات من القرن الماضي حينما زاوج ما بين سياسة الانفتاح الاقتصادي الإصلاحي في الداخل، وهجوم السلام مع إسرائيل في الخارج. ورغم ما حدث من اغتيال الرئيس المصري، فإن مبادراته الخارجية ظلت جزءاً من التراث الدبلوماسي والسياسي القائم على ضرورة تغيير «البيئة» السياسية واستثمارها في إقامة علاقات جديدة تستفيد من التجارب العالمية ليس تلك التي في أوروبا وإنما الأقرب في شرق وجنوب شرقي آسيا حيث يمكن استخلاص التعاون والاستقرار من أنياب التناقضات والصراعات في المنطقة.
مشهد «الشرق الأوسط الجديد» يبدو خارجاً من رحم صراعات كبرى ومناخ عالمي بالغ التعقيد والانقسام؛ ولكنه في ذاته يفرض المصالح المباشرة لدول الإقليم للاعتماد على الدول الراغبة ولديها الإرادة السياسية للتعاون من خلال عمليات سياسية ودبلوماسية لا تزال في مراحلها الاستكشافية الأولى. هذه العملية كسرت كثيراً من حلقات المقاطعة والرفض والحملات الإعلامية الساخنة؛ ولكنها في ذات الوقت معرضة للرياح الساخنة في داخل كل دولة والتي بعد التعود على مناخ الصراع ترى في الخروج منه نوعاً من الليونة والتنازل غير المقبول. وهي معرضة أيضا لقوى معارضة صريحة يقع في مقدمتها جماعات الإسلام السياسي التي بلغ تطرفها مبلغاً يقوم على تكفير كل نظم الحكم القائمة والتي على استعداد لنفخ النيران في أزمات وعقد تاريخية في مقدمتها القضية الفلسطينية بغض النظر عن مدى الجاهزية السياسية للنخبة الفلسطينية للتعامل مع واقع صعب ومتغير. وفي النهاية فإن الحكم على عملية استكشافية لا تزال في بداياتها الأولى تحتاج الكثير من إرادة البحث والاستقصاء للانتقال منها إلى ما هو أعلى وأرقى.
GMT 13:05 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
حزب الله بخيرGMT 11:57 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مرحلة دفاع «الدويلة اللبنانيّة» عن «دولة حزب الله»GMT 11:55 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
هل هذا كل ما يملكه حزب الله ؟؟؟!GMT 20:31 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
عشر سنوات على الكيان الحوثي - الإيراني في اليمنGMT 20:13 2024 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
صدمات انتخابيةبوتين يلوح بإمكانية وقف توريد الغاز الروسي للأسواق الأوروبية فورًا
موسكو - العرب اليوم
لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية توقف روسيا عن توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى. وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها &...المزيدمنافسة باردة بين محمد سامي وعمرو سعد بعد نجاح مسلسل الست موناليزا
القاهرة ـ العرب اليوم
يشهد سباق الدراما الرمضاني منافسة من نوع آخر، وحربا باردة بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد، بسبب التنافس على لقب الأعلى مشاهدة في رمضان. محمد سامي الذي يغيب عن الموسم هذا العام، تتواجد زوجته الفنانة مي عمر، من...المزيدميتا تخفف قيودها على روبوتات الدردشة في واتساب
واشنطن ـ العرب اليوم
في محاولة لتفادي فتح تحقيق واسع من قبل المفوضية الأوروبية، أعلنت شركة “ميتا”، أنها ستسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بتقديم روبوتات الدردشة الخاصة بها عبر تطبيق واتساب باستخدام الواجهة الخاصة بتطبيق واتساب WhatsAp...المزيداستقالة مديرة متحف اللوفر على خلفية حادثة سرقة جواهر التاج البريطاني
باريس ـ العرب اليوم
استقالت مديرة متحف اللوفر الشهير في باريس، الثلاثاء، على خلفية سرقة جواهر التاج البريطاني التي بلغت قيمتها 88 مليون يورو (100 مليون دولار) العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "سرقة القرن". وأعلن الرئيس الفرنسي إي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©