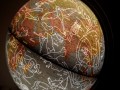الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ثورات الشتاء..!
ثورات الشتاء..!

بقلم - عبد المنعم سعيد
كانت المصادفة وحدها هى التى وضعت فى طريقى، قبل أيام، واحدًا من تلك الكتب عن الثورة، ولم يكن عن ثورة واحدة، وإنما فى كتاب تتجاوز صفحاته الألف، كانت هناك قائمة طويلة من الثورات التى جرت فى القرن الواحد والعشرين.
الكتاب حرره ثلاثة من المحررين- أندرى كورتاييف، وجاك جولد ستون، وليونيد جليفين- تحت عنوان «دليل الثورات فى القرن الواحد والعشرين» وعنوان تابع «الموجات الجديدة من الثورات، أسباب ونتائج قطع مسار التغيير السياسى».
الكتاب الصادر فى العام الماضى- ٢٠٢٢- عن دار نشر سويسرية، من نوعية الكتب الموسوعية، التى تتعامل مع ظاهرة الثورة مبدئيًّا من أجل المقارنة بثورات القرنين التاسع عشر والعشرين، تلك الثورات التى جرَت فى قرن هنا، وأخذت اسم «الربيع» المسجل بأسماء الزهور «الياسمين واللوتس» والألوان البرتقالية والبنفسجية، وهكذا تقسيمات.
ولم تكن هناك مصادفة أن ثورات «الربيع العربى» أخذت جزءًا محترمًا من المجلد، وكان طبيعيًّا أن يكون فى القلب منها ما جرى فى مصر فى مطلع العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين.
وتاريخيًّا كانت الثورات تحدث عادة فى شهر يوليو فى قلب الصيف القائظ، وأصبحت فجأة تحدث فى شهر يناير، حيث الشتاء القارس والزمهرير، الذى يلفح الوجوه.
والحقيقة أنه فى مصر لم يشهد شهر يناير ثورة واحدة تحتفى بوجودها الجماعة السياسية المصرية مدحًا وذمًّا اليوم بعد مرور دستة سنوات على حدوثها. كانت هناك ثورة أخرى جرت قبل ذلك، وربما لو قُدِّر لها النجاح لما كانت هناك ضرورة لما لحق من ثورات.
مضت أربعة وأربعون عامًا على وقوع هذا الحدث الهائل عندما خرج المصريون بمئات الألوف أو قيل بالملايين فى ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع التى لم يكن أحد ينتجها إلا الحكومة.
القصة ربما بدأت فى أكتوبر ١٩٧٣ حينما وجد الشعب المصرى أن بمقدوره أن يتجاوز هزيمة كبرى حفرت فى أعماقه إحساسًا بالمهانة، فإنه لم يقدر أن النتيجة حدثت بفعل عمل شاق وعرق غزير ودماء كثيرة.
كان ذلك ما أراده تحديدًا الرئيس أنور السادات عندما وضع سياسة الانفتاح الاقتصادى، التى لم تكن تعنى إلا الكثير من العمل، والكثير من الإنتاج والتصدير والانفتاح على عالم آخذ فى التقدم على جميع الجبهات.
علينا ألّا ننسى أنه فى عام ١٩٧٧ ومن بعده عام ١٩٧٨ كانت الأعوام التى اتخذت فيها الصين قرارًا مصيريًّا بأن تشمر عن ساعديها وتعمل بكل قوة أكثر مما تتكلم بكل حماسة الكتاب الأحمر، وكانت ذات الأعوام التى وُلدت فيها «النمور الآسيوية»، التى قررت فيها دول أن تعتمد على نفسها، وهو ذات القرار الذى لم تتأخر فيتنام ذاتها فى اللحاق به قبل نهاية القرن العشرين.
ضاعت الفرصة فى مصر، فى وقت بات العالم ينظر لها نظرة مختلفة عما كان يظنه فيها من قبل؛ ولم تتوقف السياسة التنموية فقط، وإنما لحقها اغتيال الرئيس السادات. وعلى مدى عقد كامل من ثمانينيات القرن العشرين، ظلت قصة ثورة الخبز وقتل رجل الحرب والسلام حاكمة وآمرة بإدارة الفقر، وتلافى الإصلاح الذى لا يأتى إلا بآلام كثيرة لا يريد أحد تحملها متصورًا أن الدول تتقدم من خلال ما يأتى إلى جيوب مواطنيها، وليس من خلال إقامة الصروح ونشر العمران وسهر الليالى للعمل والإبداع.
لم يكن مفهومًا ليس لماذا قام المصريون بثورة الخبز، وإنما لماذا سكتوا بعدها لعقد كامل، بينما العشوائيات تنتشر، والفكر السلفى يسود، ولماذا لم يعد السؤال: لماذا تخلفنا؟، مطروحًا، ولا تساءل أحد عن زيادة الإنتاجية للعامل ولا لرأس المال، وعندما نشبت ثورة يناير التالية فى ٢٠١١ فإن هذه الأسئلة لم تكن مطروحة.
كان الهتاف مطالبًا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولكن بعد ذلك لا شىء، وبقدر ما كان مطلوبًا زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحديد الحد الأعلى للأجور مهما كانت الكفاءة والعلم والقدرة والمهارة والإبداع؛ فإنه لم تكن هاك إشارة واحدة للعمل ولا للإنتاجية.
كان لكل ذلك أن ينتظر حتى تأتى ثورة أخرى، فى يونيو ٢٠١٣ هذه المرة، وفيها ربما آلت إلى طريق يضع مصر فى طريق الصين وفيتنام ودول أخرى.
هذه قصة جديدة، وآفة حارتنا قد لا تكون فقط هى النسيان، وإنما أن نطرح الأسئلة: لماذا تخلفنا؟، ولماذا يستمر تخلفنا؟، وهل نريد لمصر حقًّا أن تكون قوية وعظيمة ومتقدمة، وتستحق منا الكثير من الجهد والتفكير والتجديد والتقييم لما حدث؟.
GMT 13:05 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
حزب الله بخيرGMT 11:57 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مرحلة دفاع «الدويلة اللبنانيّة» عن «دولة حزب الله»GMT 11:55 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
هل هذا كل ما يملكه حزب الله ؟؟؟!GMT 20:31 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
عشر سنوات على الكيان الحوثي - الإيراني في اليمنGMT 20:13 2024 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
صدمات انتخابيةالمخاوف من عدم إستقرار قيمة الدولار تتزايد بسبب سياسة ترامب الإقتصادية
واشنطن - ماريّا طبراني
مشهد هبوط وصعود قيمة العملات النقدية العالمية أمر إعتيادي في الأسواق ، لكن ما حصل من تراجع لسعر صرف الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة كان غير عادي على الإطلاق . إذ كان سعر صرف الدولار في صعود أثناء الخ...المزيدشيرين عبدالوهاب تعود للساحة الفنية وتشيد بدراما رمضان وتبدي إعجابها بمسلسل "إخواتي"
القاهرة ـ العرب اليوم
غابت شيرين عبدالوهاب لفترة طويلة عن الظهور، بعدما شاركت في إحدى الإعلانات في شهر رمضان الماضي، وكذلك مشاركتها في إحدى حفلات عيد الفطر، وبعد فترة من الغياب، فسره البعض باهتمام الفنانة المصرية بمتابعة بعض الأعمال ا�...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©