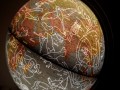الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
المهاجر
المهاجر

بقلم: عادل درويش
في البيان الوزاري التقليدي في وستمنستر عن أحداث الشغب في مظاهرات الأسبوع الماضي، تعرضت وزيرة الداخلية بريتي باتيل للمساءلة بقيادة نظيرها في حكومة الظل (المعارضة العمالية) نيقولاس توماس - سيموندز، حول القصور وكيفية تعديل الإجراءات لتجنب تكرار متاعب في المستقبل. المظاهرات كانت مسيرات مستمرة نظمتها مجموعات غير واضحة الأهداف والعضوية، «كحياة السود تعنينا»، «وتحالف مناهضة الفاشية»، و«الزخم»، و«العاملون الاشتراكيون»، تقليداً للمظاهرات العنيفة التي اندلعت في مدن الولايات المتحدة، إثر موت الأميركي الأسود جورج فلويد مخنوقاً بضغط رجل بوليس أبيض على رقبته لتسع دقائق في مينيابوليس؛ مبرر معقول لأن تحتل مناقشة العنصرية في المجتمع جانباً معتبراً من الجلسة البرلمانية.
الأمر المحير أن تستنفد المعارضة، من نواب يسار العمال والقوميين الاسكوتلنديين، معظم وقت الجلسة في توجيه تهم العنصرية لحكومة المحافظين، التي تمثلها وزيرة داخلية سمراء البشرة، من أسرة هندية عاشت في شرق أفريقيا، واضطرت إلى اللجوء لبريطانيا بعد طردهم لأسباب سياسية. ويشاركها في العرق والظروف وزراء آخرون مثل رانيل غاياوارنيا وزير التجارة الدولية، وريشي سونار وزير المالية، ثاني أقوى منصب في بريطانيا، أبواه أيضاً من الهنود الذين رحلوا من شرق أفريقيا، وأيضاً الهندية الأصل سويلا بيرفيرمان، رئيسة مكتب النيابة العامة، وهو منصب في مجلس الوزراء. أما ساجد جاويد، الباكستاني الأصل، أول وزير مسلم للداخلية، فالمالية فيراه المراقبون الابن الناجح في مدرسة مارغريت ثاتشر.
اللورد طارق أحمد وزير شؤون الكومونولث وآسيا من مواليد باكستان، بينما ناظم زهاوي، الوزير البرلماني للأعمال والصناعة، من مواليد بغداد لأبوين كرديين، اضطررت الأسرة، وهو في التاسعة، للجوء لبريطانيا فراراً من بطش صدام حسين. وزير التجارة والأعمال إيلوق شارما من مواليد سيرلانكا (سيلان)، أما جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية، فابن مهاجرين من سيراليون، والأفريقية الأخرى كيمي بيدنوك وزيرة الدولة لشؤون الخزانة من أسرة نيجيرية.
لا يتسع المجال لذكر جميع الأسماء من المسلمين والعرقيات الأجنبية، التي تتغافل صناعة الرأي العام ذكرهم كمجموعة لموازنة تهمة العنصرية الموجهة لحكومة بوريس جونسون. في مقابلات تلفزيونية في اليوم نفسه مع وزير الصحة ماثيو هانكونك، ركز المذيعون على اتهامات العنصرية للحكومة، أكثر مما ركزوا على المسائل الطبية، رغم تفشي وباء «كوفيد - 19» وارتفاع الوفيات لأكثر من أربعين ألفاً.
وزيرة الداخلية باتيل شنَّت هجوماً مضاداً في مجلس العموم، رداً على تهمة العنصرية. وصفت كيف تعرضت للإهانات العنصرية في طفولتها وشبابها، لكنها رفضت أن تكون ضحية، وتعاملت مع التحديات بالمثابرة والتفوق. باتيل اتهمت المعارضة اليسارية «في البرلمان وخارجه» بالعنصرية رغم قياداتهم المسيرات تحت راية مكافحة العنصرية. اليسار في قاموسها تجاوز المعارضة البرلمانية ليشمل الصحافة الليبرالية والمثقفين، وهم عادة يساريون، وأغلبهم من البيض من أبناء الطبقات الميسورة. الوزيرة ضربت مثلاً بكاريكاتير في «الغارديان» رسموها على شكل بقرة سوداء في منخارها سلسلة عبودية ذهبية يجرها رئيس الحكومة جونسون. أسرة باتيل هندوسية، والبقرة لديهم مقدسة، وكلمة بقرة أيضاً سبة قبيحة للمرأة في الفلكلور الشعبي الإنجليزي. الوزيرة تساءلت ماذا سيكون رد فعل نواب العمال وقراء «الغارديان» من المثقفين الليبراليين، لو كان الرسم لزعيمة عمالية في صحيفة تدعم المحافظين؟
اليسار البريطاني (والأوروبي) إما يخفي عنصريته تحت قناع الاحتجاجات على قضايا، بعيدة جغرافياً كعنف البوليس في أميركا؛ أو أن أكثرهم عنصريون في اللاوعي، أو مزيج من الاثنين. اليسار الأوروبي لا يسمح بخروج المهاجرين وغير البيض من إطار الصورة النمطية: الضحية الغاضبة دائمة الاحتجاج التي يجب أن تثور على المستعمر (ويتهمون المحافظين بأنهم استمرار للكولونيالية كمبررهم المعلن لتشويه تماثيل زعماء كونستون تشرشل)، والثورة بإشارة من السادة المثقفين «البيض»، وبقيادتهم فقط. شخصيات قوية كباتيل أو رجال أعمال ناجحين كساجد جاويد وناظم زهاوي، تواجه هؤلاء المثقفين بمعضلة لأنها تقوض فلسفتهم. فإظهار المهاجرين والعرقيات غير البيضاء على أنهم ضحية فقط، هي عنصرية بمعاملتهم على أنهم أقل قدرة على النجاح من البيض. الإحصائيات بيَّنت أن أبناء المهاجرين، خاصة المسلمين، واليهود ومهاجري القارة الهندية، نسبة تفوقهم الأكاديمي، خاصة بين الإناث، أعلى من نسبتها بين البيض بما بين 30 في المائة و40 في المائة.
ظاهرة التوجس من المهاجر الناجح، وإهانته، لا تقتصر على المثقف البريطاني. صحافيون عرب أثاروا مناقشة على «فيسبوك» باتهامات سلبية لساسة ووزراء محافظين (على جانبي الأطلسي) من غير البيض، واتهامات بالانتماء «لليمين المتطرف» «ودعم العنصرية» للمهاجرين في الغرب من أصول أو مواليد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنهم لا ينتمون لحركة التمرد اليساري، أو لأنهم من مرشحي المحافظين، أو من المستثمرين ورجال الأعمال، أي خرجوا من إطار الصورة النمطية للمهاجر. آلاف من هؤلاء المهاجرين، مثل نماذج، الوزراء البريطانيين أعلاه، تعرضوا لظروف قسرية لا اختيارية جعلتهم أوروبيين أو أميركيين، كالهرب من بطش حاكم قتل شعبه بالكيماوي، أو طردهم ديكتاتور استولى على السلطة بأسلوب غير شرعي وسلبهم ممتلكاتهم كعيدي أمين (1925 - 2003) وأمثاله، ولأنهم كانوا أقلية عرقية في بلدان الطرد، فقد وجدوا في الغرب مجتمعاً كوزموباليتنياً اندمجوا في نسيجه الاحتضاني الشامل، بدلاً من النشاز رفضاً واحتجاجاً، أو الانعزال في «غيتو» ثقافي اجتماعي.
الملاحظة الأخرى، أن مثيري مناقشة التواصل الاجتماعي أنفسهم، ليسوا بمهاجرين دائمين، وإنما مروا ببلدان الغرب، عاملين، مباشرة بلا كفيل، لفترات محدودة في مؤسسات صحافية وتجارية أكاديمية، في مساواة تامة مع السكان الأصليين، أي كانت أوروبا جسوراً مهنية، انتقلوا منها إلى بلدان عربية بخبرة ضمنت مركزاً متميزاً نسبياً. ولكنهم لا يزالون يعتبرون أن المهاجرين، قسراً أو اختياراً، من بلدانهم إلى أوروبا وأميركا، لا يزالون «ضحية» وغير متساوين بالأوروبي الأبيض، فكيف ينتمون إلى فئات النجاح الفردي بالاستثمار أو النجاح السياسي لأنهم يرون أنفسهم يستحقون التفوق؟ هل يرون، ربما لا شعورياً، أن المهاجر من هذه البلدان لا يزال دون المساواة مع الأوروبي أبيض البشرة؟ وحتى تخرج دراسات الاجتماع الانثروبولوجي بتفسير آخر، فظني أنه وراء دفع «الفيسبوكيين» من أفريقيا والشرق الأوسط لتقليد اليسار الأوروبي في إدانة وإهانة مهاجري مناطقهم، الرافضين لعب دور الضحية الساعين إلى التفوق في كل المجالات مساواة بالأوروبي الأشقر.
GMT 08:40 2025 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
جانب فخامة الرئيسGMT 06:34 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
المصريون والأحزابGMT 04:32 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
رسائل الرياضGMT 04:28 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
د. جلال السعيد أيقونة مصريةGMT 04:22 2025 السبت ,05 إبريل / نيسان
إيران وترمب... حوار أم تصعيد؟المخاوف من عدم إستقرار قيمة الدولار تتزايد بسبب سياسة ترامب الإقتصادية
واشنطن - ماريّا طبراني
مشهد هبوط وصعود قيمة العملات النقدية العالمية أمر إعتيادي في الأسواق ، لكن ما حصل من تراجع لسعر صرف الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة كان غير عادي على الإطلاق . إذ كان سعر صرف الدولار في صعود أثناء الخ...المزيدشيرين عبدالوهاب تعود للساحة الفنية وتشيد بدراما رمضان وتبدي إعجابها بمسلسل "إخواتي"
القاهرة ـ العرب اليوم
غابت شيرين عبدالوهاب لفترة طويلة عن الظهور، بعدما شاركت في إحدى الإعلانات في شهر رمضان الماضي، وكذلك مشاركتها في إحدى حفلات عيد الفطر، وبعد فترة من الغياب، فسره البعض باهتمام الفنانة المصرية بمتابعة بعض الأعمال ا�...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©