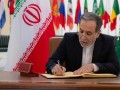الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
«رئيسي ـ ماكرون»... أو النسخة الجديدة من «سايكس ـ بيكو»
«رئيسي ـ ماكرون»... أو النسخة الجديدة من «سايكس ـ بيكو»

بقلم - إياد أبو شقرا
مجازاً، يمكن القول إن قلة من القوى الدولية والإقليمية لم تسهم في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. لكن الواقع أن هذه الحكومة، أو بالأصح «التشكيلة الوزارية»، لا تحكم بقدر ما تدير أزمة مُستحكمة بات حلّها جزءاً لا يتجزأ من الصيغة الإقليمية الكبرى الجاري إعدادها للشرق الأوسط في ظل متغيرات كبرى.
هنا قد يقول قائل: لمَ الإفراط في التعقيد والتشاؤم بعد الخروج من نفق مظلم مضى على دخول لبنان فيه أكثر من سنة؟ تفاءلوا بالخير تجدوه.
وقد يقول آخر في براغماتية تدعي الحكمة إن إنارة شمعة خير من لعن الظلمة. ويكفي أن هذه الخطوة ستخفف من معاناة المواطنين المنكوبين بساستهم، وتبطئ نزف الهجرة، وتلجم جزئياً انهيار الاقتصاد والسقوط الحر لنظام سياسي سيئ معيب.
وقد ينبري ثالث ليجادل بأن العالم بأسره يمرّ بأزمات بنيوية فاقمتها الأوبئة وآفات التغير المناخي، وتهديدات التطور التكنولوجي السريع لأنماط العمالة التقليدية، واهتزاز مفهوم «الدولة الأمة» مع تصاعد العنصرية كرد فعل ضد العولمة والهجرة واللجوء وحرية التنقل، ناهيك من صعود قوى عالمية جديدة ذات ثقافات سياسية مختلفة على المسرح الدولي منافسة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
كل الذي تقدّم صحيح. ولكن صحيح أيضاً أن القراءة الواقعية لتتابع الأحداث تنجي من مزالق التفاؤل الحالم والجهل المطمْئن. وعليه، لا ضير من ربط الأمور بميزان التجارب والخبرات، والتعامل معها... كما هي على الأرض، لا كما نتمنى ونرجو.
بدايةً، ما عاد سراً أن النظام الإقليمي الذي رسم حدود منطقتنا خلال القرن الماضي انتهى إلى غير رجعة. وهو ما يعني أن على المراقب مقاربة المستجدات بعيداً عن العواطف والمثاليات.
مفهوم العروبة الذي ألِفناه تبدّل وتبلور مراراً عبر العقود... من هويّة لا تحتاج عند العامة لمَن يفلسف تعريفها إلى عقيدة قومية مناوئة لقومية «تركية - طورانية» جديدة نشأت في دولة الخلافة العثمانية على أنقاض الهوية الإسلامية الجامعة.
العرب - المسلمون السنّة منهم على الأقل - ارتضوا الحُكم العثماني في ظل «خليفة» غير عربي طالما كان حكماً يساوي بين الشعوب المسلمة، إلا أن الأمر اختلف في القرن الـ19 مع حركات النهوض القومي في أوروبا والدولة العثمانية. وبوجه «التتريك» الفوقي للدولة كان متوقعاً ظهور رد فعل ذي طبيعة مشابهة لكن في اتجاه معاكس. ثم تسارع زخم رد الفعل هذا مع رعاية الدول الأوروبية البديل القومي العربي... لا حباً بالعرب بل لحاجتها أساساً لإضعاف الغريم العثماني.
وبالفعل، بعد انهيار الدولة العثمانية إثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، رفضت القوى الأوروبية المنتصرة التعامل مع العرب كـ«أمة واحدة» ذات مصلحة واحدة، بل قسّمت المنطقة إلى مناطق نفوذ. وقد تكون المسميات والأساليب... وحتى بعض الظروف والأوليات والتحالفات قد تغيّرت اليوم، لكن عنصر «المصلحة» في السياسة يبقى الثابت الوحيد.
بعد الحرب العالمية الأولى، كما نتذكر، كان الأساسان اللذان حدّدا الهويات الجديدة للولايات والمناطق العثمانية السابقة «اتفاقية سايكس – بيكو» و«إعلان بلفور». ولاحقاً، تتابعت المفاصل بما فيها فصل السودان عن مصر، وترسيم الحدود في شبه الجزيرة العربية، ثم نهاية الانتدابين البريطاني والفرنسي في المنطقة إبان وبعد الحرب العالمية الثانية. أما اليوم، فعلينا الإقرار بواقع جديد، قد يكون مؤلماً لكثيرين لكنه حقيقي، هو أن عدداً من كياناتنا تغيّرت سياسياً وديموغرافياً وثقافياً واقتصادياً.
بعض هذه الكيانات، كانت قبل تأسيسها «مراكز ثقل» إقليمية، حتى إن لم تكن «دولاً» قائمة بذاتها بحدود متفق عليها وهوية جامعة لمعظم سكانها. أما البعض الآخر فوُلد لاعتبارات استراتيجية وتوازنات ومساومات آنية. والغريب أننا بتنا راهناً لا نميّز بين هاتين الفئتين في ظل حالة التقسيم الواقعي وانهيار الهويات الجامعة.
ثم إننا، كنّا كعرب قد رفضنا لعقود وبعناد يدعو إلى الإعجاب حدود «سايكس - بيكو» و«حدود إعلان بلفور». وأيضاً عبر العقود قامت زعامات وأسّست أحزاب وأطلقت شعارات وفجّرت حروبا بحجة إسقاط هذه الحدود «التقسيمية»، غير أننا - كما يكرّر بعضنا - تدهورنا من أزمة «التقسيم» إلى جحيم «التفتيت». بل والمفارقة الأفظع، أن هذه الحدود التي فشلنا في إسقاطها... يزيلها الآن خصومنا الإقليميون، لأن أطماعهم وطموحاتهم وتعاطف القوى الكبرى معهم، أقوى بكثير من ضعفنا وانقسامنا وسوء تخطيطنا ومحدودية فهمنا لـ«لعبة الأمم» المحيطة بنا.
العراق اليوم، بعد 2003، صار «عراقاً آخر» تحكمه اعتبارات سياسية وديموغرافية وآيديولوجية مختلفة. وهو مع تأهب القوات الأميركية لمغادرته على أبواب مرحلة جديدة من بناء دولة مجزوءة الاستقلال والوحدة في ظل توسّع إيراني أمني وتنظيمي متغلغل في مفاصل الدولة العراقية بالعمق. والواضح أن هذا التوسّع، الذي ما عاد يقتصر على العراق المتاخم لإيران، بل تجاوزه إلى سوريا ولبنان وبعض فلسطين... يحظى بـ«حُسن نية» من قوى أوروبية ما عادت ترى في طهران إلا شريكاً اقتصادياً وأمنياً مفيداً.
أما سوريا، فهي اليوم مسرح أكثر تلوّناً في حسابات مناطق النفوذ وتقاطعات المصالح. وهنا وسط التشقّق السوري الداخلي يتعايش الطموح الإيراني مع الأطماع الروسية بصورة لافتة، مع إقرار «المُتعايشين» بمصالح أخرى ذات أبعاد جيو - سياسية أميركية وإسرائيلية وتركية. ومن تجلّيات هذه الحالات من التعايش على حساب الكيان السوري - وطبعاً الشعب السوري - «الممرّات» و«مناطق النفوذ» المتفاهم عليها علناً أو سراً.
وأخيراً لبنان.
في لبنان كشفت التقارير خلال اليومين الأخيرين أن اتصالات إقليمية ودولية نجحت في «تذليل العقبات» المزعومة التي حالت دون تشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب المستقيلة في أغسطس (آب) 2020، ومن استعراض أسماء الجهات الأجنبية التي ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حل الأزمة المتطاولة... يخرج المحلّل باقتناع أننا أمام صفقة إقليمية لها ما لها وعليها ما عليها، ولا علاقة للبنانيين بتفاصيل بنودها وشروطها.
ثم إنه من دون تعنت أو تشكيك، يثبت «التفاهم» على التشكيلة الوزارية الجديدة، أن لبنان أضحى تحت وصاية إيرانية – فرنسية، بموافقة أميركية - إسرائيلية – روسية، بانتظار تفاصيل الصفقة النووية مع إيران، وبضمنها التفاهم على سقف نفوذ إيران الإقليمي على امتداد الشرق الأوسط.
GMT 03:41 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
ثلثا ميركل... ثلث ثاتشرGMT 03:35 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
مجلس التعاون ودوره الاصليGMT 03:32 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
عندما لمسنا الشمسGMT 03:27 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
ثلاثيّ العجز عن سيطرة العقل في لبنان: «كورونا» والدولار و«حزب الله»GMT 03:18 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
رسالة إلى دولة الرئيس بريبعد أن أصبح الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين تراجعه ناجم عن جني أرباح من المستثمرين
لندن - ماريّا طبراني
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا يوم الأربعاء، بلغت 3300 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار أمريكي للأونصة، مع استمرار بحث المستث...المزيدصابرين تكشف أسرار رحلتها الفنية من الغناء إلى التمثيل وتأثير الكبار في تشكيل ملامح مشوارها
القاهرة - العرب اليوم
خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير ضمن سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد "شمّ النسيم"، فتحت الفنانة صابرين قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مشوارها الفني، وتجاربها الإنسانية، وندمها الوحيد، وت...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©