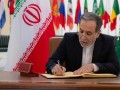الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
السعودية... ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية
السعودية... ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

بقلم - إميل أمين
حققت الدبلوماسية السعودية الأيام القليلة الماضية انتصاراً كبيراً ومهماً، حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوجه الإنساني والإيماني الخلاق، الذي طرحته المملكة، ذلك الداعي إلى تعزيز ثقافة السلام والتسامح، وحماية الأماكن الدينية من مساجد وكنائس ومعابد، تخص أبناء الأديان الإبراهيمية، أو تلك الخاصة بالهندوس أو السيخ، أو غيرهم من الطوائف.
القرار الأممي الذي وضعت السعودية لبناته قبل نحو أسبوع، يسعى لمضاعفة الجهود من أجل تشجيع الحوار على الصعيد العالمي، والترويج لثقافة التسامح والسلام القائمة على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
هل يأتي هذا التوجه كرافد تنويري ضمن روافد «رؤية المملكة 2030» التي يرعاها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؟
يمكن القطع بأن ذلك كذلك، لا سيما أن المشهد يفتح الكثير من أبواب المملكة الحضارية، ويظهر كيفية الإسلام الوسطي السمح، في تعاطيه مع الآخر، بغض النظر عن جنسه أو لونه، دينه أو عرقه؛ فالإنسان هو أولاً وآخراً القضية وهو الحل.
ما الذي تمثله بيوت العبادة للنفس الإنسانية بشكل عام، ولا سيما عند أبناء إبراهيم الخليل، عليه السلام، أولئك الذين شاءت الأقدار أن يوجدوا في هذه الرقعة الشرق أوسطية، قريبين ولصيقين من بعضهم بعضاً لآلاف السنين؟
حكماً، لأماكن العبادة الدينية مكانة عالية الأهمية، وغالية القيمة في الإسلام والمسيحية واليهودية، وكذلك الأمر في الأديان الوضعية الأخرى؛ فهي بيوت مخصصة للصلاة الشخصية والجماعية على حد سواء، وهي مبنية ومؤثثة بطريقة تساعد على التواصل مع الخالق جل وعلا، إنها فضاءات يمكن للمرء أن يتوجه بفضلها إلى أعماق نفسه؛ مما يهيئ الفرصة لخبرة روحية في صمت، فمكان العبادة لأي دين هو «بيت صلاة».
ولعل أماكن العبادة في شرقنا الفنان على نحو خاص، هي مساحات للضيافة الروحية، حيث يشترك أحياناً بعض المؤمنين من الأديان المختلفة في مناسبات خاصة مثل حفلات الزفاف والجنازات والمناسبات الاجتماعية، وغير ذلك؛ ما يجعل مشاركتهم دليلاً على ما يوحّد المؤمنين من دون تقليل أو إنكار لما يميزهم، لكن من غير أن يكون ذلك سبباً لتنافرهم أو تباعدهم.
علامة الاستفهام المهمة في هذا الحديث، «هل جاءت المبادرة السعودية التي لاقت ترحيب أكثر من ثلاثين دولة في الأمم المتحدة، في الوقت القيم والزمن الأكثر احتياجاً؟».
المؤكد أن ذلك كذلك قولاً وفعلاً، لا سيما بعد أن شهدت الأعوام القليلة المنصرمة اعتداءات على مساجد كما الحال في نيوزيلندا، وعلى كنائس كما في سيرلانكا، ولم توفر الكنس اليهودية في الولايات المتحدة، وكلها وقعت من قبل أناس أشرار، يظهر أنهم يعتبرون أماكن العبادة هدفاً مميزاً لعنفهم الأعمى والمجنون.
ما أدركته الدبلوماسية السعودية، وأحسنت كثيراً جداً إدراكه، هو أن تلك الجرائم الأخلاقية والمادية، إنما هي نتاج فكر متطرف، لا يؤمن بالآخر، ويجده عقبة في طريق سطوته وبطشه؛ فكر يظن أنه صاحب الحقيقة المطلقة وما عداها هو الزيف والضلال، ولعله من سوء الطالع أن الإنسانية معرّضة في قادم الأيام إلى تصاعد مخيف في هذا الاتجاه، وسواء كان ذلك من قبيل نشوء وارتقاء حركات عنصرية أو مذهبية جديدة، أو استدعاء للشوفينيات والقوميات القديمة، لا سيما تلك التي عانت منها القارة الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين، عطفاً على الأصوليات الشرقية التي تلاعبت بها دول وأجهزة غير خافية عن أعين الجميع.
ما الذي تهدف إليه المملكة العربية السعودية والعالم على عتبات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين؟
باختصار غير مخل، إنها ومن منطلق دورها الروحي كقبلة للعالم الإسلامي، تسعى في طريق تنمية ثقافة السلام، سواء كان الأمر يتعلق بالأفراد أو الجماعات والدول، ومن ثم جعل مثل تلك الثقافة درعاً مكينة تصد هجمات التطرف والكراهية والعنف، خاصة ما كان منها مبنياً على وجود الاختلافات بين البشر موصولاً بالأعراق أو الأديان والثقافات.
تعاني البشرية في حاضرات أيامنا، من مأساة التعاطي مع فيروس «كوفيد - 19» الشائه الذي يضرب ذات اليمين وذات اليسار.
غير أن هذه الجائحة سوف تنتهي بفضل الله وكرمه، ومن منّته على العقل البشري، الذي يجود بالمخترعات الطبية واللقاحات الحديثة.
لكن آفة زماننا وجائحته التي يحاربها القرار السعودي بكل قوته، هي الكراهية، وفراغ القلوب والعقول من المحبات، وبناء الجدران عوضاً عن إقامة الجسور.
مواقف المملكة ثابتة عبر الزمان والمكان، راسخة ومبنية على احترام الاختلاف وإدانة العدوان والإرهاب، أياً كانت مصادره أو مبرراته؛ ولهذا وجد هذا القرار طريقه إلى العالم بترحاب شديد.
لم تكتفِ المملكة بالتنظير الآيديولوجي للمشهد؛ ذلك أنها تخطط لعقد مؤتمر عالمي لدعم هذا الهدف، ليتحول الطرح النظري إلى آليات عمل على الأرض.
أبدع ما في «رؤية 2030» أنها تداعب الأحلام لتجعل منها حقائق.
GMT 08:40 2025 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
جانب فخامة الرئيسGMT 06:34 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
المصريون والأحزابGMT 04:32 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
رسائل الرياضGMT 04:28 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
د. جلال السعيد أيقونة مصريةGMT 04:22 2025 السبت ,05 إبريل / نيسان
إيران وترمب... حوار أم تصعيد؟بعد أن أصبح الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين تراجعه ناجم عن جني أرباح من المستثمرين
لندن - ماريّا طبراني
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا يوم الأربعاء، بلغت 3300 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار أمريكي للأونصة، مع استمرار بحث المستث...المزيدصابرين تكشف أسرار رحلتها الفنية من الغناء إلى التمثيل وتأثير الكبار في تشكيل ملامح مشوارها
القاهرة - العرب اليوم
خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير ضمن سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد "شمّ النسيم"، فتحت الفنانة صابرين قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مشوارها الفني، وتجاربها الإنسانية، وندمها الوحيد، وت...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©