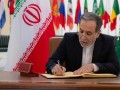الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
القوى العظمى.. يوتوبيا أم ديستوبيا؟
القوى العظمى.. يوتوبيا أم ديستوبيا؟

بقلم : إميل أمين
على عتبات الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، تطفو على السطح تساؤلاتٌ جدّيّة وجذرية بشأن التحديات التي تواجه البشرية، وهي كثيرة ومخيفة إلى حدّ المرعبة في حقيقة الحال.
البداية من عند أزمة الديون العالمية، والتي تكاد تهدد الاقتصاد العالميّ، وتدخل الجميع في نفق مظلم، تضيع فيه معالم النمو والتنمية، وتفقد خطى الاستقرار والأمن حول البسيطة مواقعها ومواضعها.
من الأمور التي تمثل بجعًا أسود، الحديث عن الوباء الغامض أو الوباء "إكس" الذي يمكن أن يضرب البشرية في أي وقت، وهناك من يرى أن تلك الأقاويل بمثابة تنبؤات تسعى لتحقيق ذاتها بذاتها، فيما السؤال الأهم هل البشرية مستعدة بالفعل لملاقاة جائحة أشدّ فتكًا من كوفيد 19؟
هناك حديث الأمن والسلم العالميين، في عالم يكاد ينزلق في هوة الحرب العالمية الثالثة، ذات المسحة النووية التي لا تبقي ولا تذر.
وما بين كل هذه الكوابيس، يبدو المناخ العالمي مطبقًا على البشرية بصورة خانقة مدمرة، وعلى غير المصدق أن يتابع أخبار الأقطاب الجليدية التي تذوب تحت شمس الغليان لا الاحتباس الحراري والعهدة على الراوي، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
والشاهد أن التحديات في طريق البشرية في حاضرات أيامنا تكاد تضحي غالبة على ميسرات الحياة، وعلى الرغم من ذلك لا تبدو النغمات السياسية السائدة تسعى في طريق سياسات الوفاق، بل الجميع ينزع نحو موجات الافتراق والتنافس بين القوى العظمى القائمة والقادمة.
يعِنّ للباحث في الشأن الأممي أن يتساءل: "هل فخ ثيوسيديديس بات الأقرب للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة على سبيل المثال؟
ثم خذْ إليك الطريق بين موسكو وواشنطن، وهل سينجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تجسير الهوة بين واشنطن وموسكو من خلال إنهاء الحرب الأوكرانية، أم أن الخرق يتّسع على الرتق.
إضافة إلى ذلك تبدو القارة الأوروبية العتيقة أمام تساؤلات جوهرية وتحديات مصيرية، لا سيما في ظل المخاوف من الضغوطات التي تحلق فوق سماواتها من جانب الرئيس ترمب، حيث يرى أن بلاده تتكبد نحو 200 مليار دولار سنويا، في حين تتمتع دول القارة بحماية شبه مجانية، ولهذا يتطلع إلى زيادة نسبة مشاركة كل دولة أوروبية بحدود 5% من ناتجها القومي، في حين كانوا يرفضون نسبة 2% في ولايته السابقة.
وبجانب ما تقدم، لا تزال هناك إشكاليات التحديات الجيوسياسية، والتي يمكن أن تتسبب في أزمات عسكرية، كما الحال في تمدد الصين في أميركا اللاتينية، ما يدفع الرئيس ترمب على سبيل المثال لمواجهة تذكر الجميع بمجريات الأحداث في كوبا خلال أوائل ستينات القرن الماضي، وقد تكون المواجهات والمجابهات هذه المرة أشدَّ قسوة، سيما أنها تتزيّا وتتخفى في الرداء الاقتصادي قبل العسكريّ.
ولعل علامة الاستفهام التي تتردد مع رئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة: "هل العالم مقبل على حرب باردة جديدة، أم حرب ساخنة؟"
هنا مرة أخرى تطفو الازدواجية الأميركية على سطح الأحداث، ذلك أن الذين استمعوا إلى خطاب تنصيب الرئيس ترمب، آمنوا بأن الرجل يودّ تقليص مساحة الصدام وأن عظمة أميركا تنطلق من الحروب التي يمكن إنهاؤها لا التي تسعى لإشعالها، غير أن سياقات الأحداث وبعد نحو أسبوعين فحسب من التنصيب لا تشي بذلك.
سريعًا بدت الخلافات التي تقود إلى المنافسة تشتدّ، ويكفي المرء ثلاثة مشاهد أممية للقطع بأن التشارع والتنازع الأممي سيد الموقف لا محالة.
لنبدأ من عند القارة الأوربية، الصديقة والحليفة للولايات المتحدة باقتدار، والضلع المتمم والمكمل لحلف الأطلسي، حيث بدت الصراعات تخرج من الخفاء إلى العلن.
لم يعد الأمر قاصرًا على الدول الأوروبية الكبرى مثل المانيا وفرنسا، حيث تصريحات أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون تقطع بالجفاء القادم، بل وصل الأمر حد دولة مثل إسبانيا أن يتحدث أعضاء في برلمانها بأن عليهم الاستعداد للغزو العسكري الأميركيّ للقارة الأوربية.
حديث الإسبان يكاد يتطابق مع رؤية الدنماركيين، حيث الرئيس ترمب يتطلّع جازمًا لوضع الأيادي الأميركية على جزيرة غرينلاند بصورة أو بأخرى، الأمر الذي جعل علماء السياسة حول العالم يعيدون قراءة العبارة التاريخية الموثوقة "الديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض".
المشهد الثاني موصول ولا شك بالعلاقات الأميركية الصينية، وهذه غالب الظنّ لا تختلف فيها مواقف الديمقراطيين عن الجمهوريين، فحتى لو كانت ولاية ترمب الأولى شديدة الوطأة على الصين، فإن إدارة بايدن بدورها، وفي استراتيجيتها الوحيدة التي صدرت عنها في أكتوبر 2022، وضعت الصين على رأس التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه الإمبراطورية الأميركية، رغم أن الصين لم تشن حروبا في ذلك الوقت، بل كان القيصر بوتين هو من استهل وقتها عملية عسكرية في أوكرانيا، أزعجت الحليف الأوروبي.
لاحقًا وفي جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ الأميركي كوزير لخارجية الولايات المتحدة الأميركية، أكد مارك روبيو على أن الصين هي "الخصم الأكثر قوة وخطورة الذي واجهته هذه الأمة على الإطلاق". وألقى روبيو باللوم على الصين بسبب الكذب والاختراق والغش في طريقها إلى وضع القوة العظمى. وأكد على الحاجة الملحة إلى تصفية المتأخرات من مبيعات الأسلحة إلى تايوان، والحد من اعتماد أميركا على الصين.
كان من الطبيعي أن ترسل الصين مباشرة بإشارات الغضب إلى حكومة ترمب الجديدة، سيما بعد أن أكد مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد مايكل والتز على الدعم الحزبي لمواجهة الصين من خلال الفعالية المعروفة باسم "تمرير العصا"، والتي تعني الاستمرار في المواجهة مع الصين خلال فترة إدارة ترمب الجديدة، من غير التوقف عند ما جرى إبان إدارة بايدن.
المرتكز الثالث في السياقات الدولية لا بدّ وأن يمر من خلال مسار واشنطن – موسكو، وهناك في الداخل الأميركي اليوم ومن حول ترمب زمرة من كبار المسؤولين ذوي وجهات النظر المختلفة، ويأمل كلّ من المتشددين والبراغماتيين في محاكاة صن تزو و"الفوز دون قتال" على الأقل كما اعترف السيناتور روبيو.
هل سيقدر لترمب الفوز في معركته مع الهوية الروسية الأرثوذكسية، كعقيدة سياسية لا دينية، من دون قتال؟
المسألة معقدة للغاية، ذلك أنه بعد أن وعد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه سينهي الأزمة الأوكرانية في المائة يوم الأولى له في البيت الأبيض، وأن أول اتصال سيكون مع الرئيس بوتين.
غير أنه وحتى الساعة، لم يصل لإسماع أحفاد القياصرة سوى تهديدات ترمب بالمزيد من العقوبات الاقتصادية، ما جعل كرامة الروس ترفض مثل هذه البداية المهينة.
المثير أن أعضاء إدارة ترمب الجدد أو الغالبية منهم يرون العالم يعود إلى الخلف، وعلى غير المصدق أن يراجع تصريحات "جون راتكليف" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلال جلسة تعيينه حيث يعتبر أنه من المرجح أن تتضمن المنافسة بين القوى العظمى صراعات متزامنة وتعاونًا متزايدًا بين القوى الرجعية وهي في تقديره الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران أو محور الشر الجديد.
هل عالمنا على موعد مع الديستوبيا أو الفوضى العالمية، أم أن لغة العقلاء واليوتوبيا، والسعي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البشرية هي التي ستسود في نهاية المشهد؟
GMT 22:05 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
إفطار رمضانى مع وزير الخارجيةGMT 22:04 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
صورة تحكى عن عطلة فى طنجةGMT 20:15 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
مفهوم العدالة بين نوزك وجون رولزGMT 20:12 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
من روائع أبي الطيب (35)GMT 20:12 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
من روائع أبي الطيب (35)GMT 12:25 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
إيران ورهان العودة إلى سورياGMT 12:24 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
يعيشون في جهنم و….!GMT 12:23 2025 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس
تحديات شرق أوسطية ضاغطةتراجع الأسهم في أميركا وآسيا بسبب مخاوف من رسوم ترامب الجمركية
واشنطن - العرب اليوم
انخفضت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا بسبب المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ذلك بعد أن قال ترامب في مقابلة تلفزيونية إن أكبر اقتصاد في العا...المزيديسرا تقيّم أعمال رمضان وتؤكد أنها لا تحب المشاركة في الموسم لمجرد التواجد
القاهرة ـ العرب اليوم
نجمة لا يختلف عليها أحد، تدعم الجميع ومعروف عنها حب الخير والسعي من أجله، فنانة من الطراز الأول، ينتظر الجمهور أعمالها بشغف، ورغم عدم تواجدها في السباق الرمضاني فإن حضورها مميز ودعمها لأصدقائها ظاهر. وكشفت النج...المزيد"إكس" تتعرض إلى هجوم سيبراني ضخم
واشنطن - العرب اليوم
بعد ساعات من سلسلة الأعطال التي تعرضت لها خدمة منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مما أدى إلى حرمان آلاف المستخدمين منها، أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك المنصة تعرضها لهجوم سيبراني ضخم. وكتب ماسك في منشور "نتعر�...المزيدالأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني بحثا الأوضاع في لبنان والمنطقة
الرياض ـ العرب اليوم
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، وس�...المزيدشرب المياه بكثرة في السحور يساعد في تقليل العطش أثناء الصيام ولكن ليس بنسبة 100%
القاهرة - سعيد الفرماوي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©