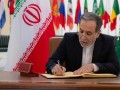الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
المدرسة.. بئر معطلة
المدرسة.. بئر معطلة

بقلم: د. محمود خليل
لم تتغير مجموعة المعادلات الأساسية التى تحكم النظرة إلى التعليم بين الأمس واليوم، سواء على مستوى الهروب من المدرسة، أو ترجيح الشهادة على التعلم.فمنذ عمليات الهروب الأولى من مدارس الوالى محمد على تواصلت المسألة طوال العقود الماضية، حتى وصلنا إلى حال باتت فيها المدارس آباراً معطلة، فالأهالى يسجلون أطفالهم فيها، ولا يهتمون بعد ذلك بذهابهم إليها من عدمه، والغالبية تبرر ذلك بغياب الخدمة التعليمية داخل المدرسة، وأنهم يعوضون ذلك بالدروس الخصوصية أو مجموعات التقوية ثم السناتر. بظهور «سنتر الدروس الخصوصية» لم يعد للمدرسة من دور إلا «الامتحان» ومنح «الشهادة».
الجهة المسئولة عن التعليم تعانى، وعندما يسألها أحد عن مستوى جودة الخدمة تحدثه حديثاً واقعياً عن الإمكانيات، وعن الأهالى الذين أدمنوا الدفع بأولادهم إلى السناتر والمدرسين الخصوصيين، وثورتهم العارمة حين تحاول تصحيح الأوضاع، ورفض الناس مشروعات التطوير التى تتبناها.
وعندما تسأل الأهالى -فى المقابل- عن اتهامات الجهة المسئولة عن التعليم لهم، يجيبونك إجابة واقعية عن أوضاع المدارس وقدرتها الاستيعابية، وقلة عدد المدرسين، وهى عوامل تدفعهم للجوء إلى بديل المدرسة «السنتر»، وتبرّر لهم أيضاً اللجوء إلى الغش، جرياً على قاعدة «كله خربان»، وقناعة منهم بأنهم دفعوا الكثير، وليس من السهل عليهم بعد الدفع أن يتنازلوا عن الشهادة.
الموضوع المشترك هو «الشهادة» المختومة رسمياً، الجهة المسئولة تريد منحها بشروطها، والأهالى يريدونها بثمنها، أما العلم فلا يوجد طلب عليه، سواء كان رسمياً أو شعبياً، بل قل إنه يضر -حين امتلاكه- أكثر مما ينفع، لأنه يجلب المشكلات فى الأغلب.
ولك أن تعلم أن الجدل حول ثنائية العلم والشهادة كان شائعاً خلال القرن الماضى، يكفى أن تستدعى فى هذا السياق حالة الغبن التى كان يشعر بها واحد من أكبر مفكرى ذلك الزمان، وهو الأستاذ عباس محمود العقاد، أمام عميد الأدب العربى طه حسين، لأن العميد حاصل على الدكتوراه، فى حين أن الأول حاصل على الشهادة الابتدائية، لكنه قرأ فى الفكر والفلسفة والعلوم ما لم يقرأه أعتى المتعلمين وحاملى الشهادات.
كان «العقاد» يعلم أنه أكبر من عشرات الحاصلين على الدكتوراه، بما أنتجه من بحوث ومؤلفات، لكن المؤكد أن المجتمع ذاته لم يكن يؤمن بما يؤمن به الرجل، ويعتبر الشهادة الدليل الأكبر على حيازة العلم، رغم التقدير الجارف الذى حظى به المفكر الكبير بين المثقفين. لا يُقلل ذلك بالطبع من قيمة طه حسين وتأثيره، لكن علينا ألا نغفل أن التعليم الحقيقى المحرّض على التفكير الذى امتاز به العميد اكتسبه فى جامعات الخارج، وليس فى بر المحروسة.
خلال النصف الأول من القرن العشرين كان هناك جدل حول العلم والشهادة، وهو الأمر الذى اختلف خلال النصف الثانى منه، إذ يمكننا القول إن المسألة حُسمت لصالح الشهادة، بعد أن تآكل الطلب على العلم بصورة محسوسة، وباتت الورقة المختومة أهم من التعليم حتى ولو كان حاملها لا يجيد القراءة والكتابة. فليس ذلك مهماً فى واقع لا يهتم كثيراً بقاعدة الكفاءة.
GMT 06:23 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
المبحرونGMT 06:20 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
قرارات أميركا العسكرية يأخذها مدنيون!GMT 06:17 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
تسالي الكلام ومكسّرات الحكيGMT 06:14 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
كيف ينجح مؤتمر القاهرة السوداني؟GMT 06:11 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
اكتشافات أثرية مهمة بموقع ضرية في السعوديةبعد أن أصبح الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين تراجعه ناجم عن جني أرباح من المستثمرين
لندن - ماريّا طبراني
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا يوم الأربعاء، بلغت 3300 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار أمريكي للأونصة، مع استمرار بحث المستث...المزيدصابرين تكشف أسرار رحلتها الفنية من الغناء إلى التمثيل وتأثير الكبار في تشكيل ملامح مشوارها
القاهرة - العرب اليوم
خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير ضمن سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد "شمّ النسيم"، فتحت الفنانة صابرين قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مشوارها الفني، وتجاربها الإنسانية، وندمها الوحيد، وت...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©