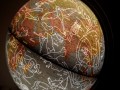الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
«تصيين» العالم: تحديات الاستجابة للتوازنات الدولية الجديدة
«تصيين» العالم: تحديات الاستجابة للتوازنات الدولية الجديدة

بقلم - يوسف الديني
قبل سنوات عدّة حضرت ورشة بحثية في باريس تحت عنوان لافت «تصيين العالم»، تناولت النفوذ المتعاظم للصين والقوة الناعمة الملتبسة برافعة اقتصادية وقدرة مذهلة على ابتلاع الفراغات الغربية في دول العالم النامية ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تراجع حضور الولايات المتحدة أو اقتصار دورها على لعب دور شرطي العالم عن بُعد، من خلال سياسات الإرغام والعقوبات الاقتصادية، أو الضغط من خلال ملفات حقوقية. واللافت أن بدء الحضور الصيني بنسخته الجديدة حرص على الشراكات الاقتصادية والقوة الناعمة، متجنباً بشكل واضح أي تدخلات سيادية في شؤون الدول؛ مما منحه عامل جذب سياسي، وقيمة مضافة إلى الفتوحات الكبرى على مستوى الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، والاستفادة من المنجزات الرقمية في تعزيز مركزية الدولة واستقرارها؛ وهو ما حول مراكز الأبحاث الغربية وخزانات التفكير إلى خلية نحل تحاول تخصيص الكثير من تحليلاتها وأوراقها صوب المارد الصيني، خصوصاً مع ارتباط نفوذ الصين في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات مستدامة مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق (BRI).
المبادرة ليست عابرة في الرؤية الصينية، بل تعتمد على مد جسور التعاون الاقتصادي في سبيل تجنّب الخلافات السياسية أو على الأقل تأجيلها بهدف اجتراح بنى تحتية عالمية وطموحة لخلق شبكة اتصالات تكنولوجية ولوجيستية فائقة السرعة والذكاء لتمرير المنتجات الصينية التي تغمر العالم مع تراجع الصورة النمطية عن جودتها وقدرتها على المنافسة، وكلنا يتذكر قبل أيام حديث أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة «أبل» الذي بدا وكأنه مانفيستو صارخ ضد التنميط الغربي تجاه الصين، وأن اختيار الشركات الكبرى ليس كما تزعم الصورة النمطية مبني على العمالة الرخيصة التي تعيش تحت أوضاع إنسانية مزرية، وإنما بسبب التخصص الدقيق والتدريب الفائق على التفاصيل الصغيرة للمنتجات التي تستهدفها الشركات التقنية الكبرى، وهو - بحسب تصريحه - ما ليس متاحاً بذات الكفاءة والسعر في أي بلد آخر، وأنه جاء نتيجة عقود من تصحيح أوضاع سوق العمل ومخرجات التعليم، حيث البقاء للمهارة والاحترافية، وليس مجرد الاعتماد على الدراسة الأكاديمية والشهادات الجامعية على أهميتها، لكنها يجب ألا تكون قارب النجاة الوحيد للأجيال الجديدة التي تبحث عن فرص لائقة في سوق العمل، وهذا درس وإن قيل في سياق نقد التعامل الغربي مع الصورة النمطية عن الصين، إلا أنه ينسحب على استراتيجيات التفكير في المستقبل بمنظور عملي جديد يتجاوز القوالب التقليدية.
سعي الصين الطموح لابتلاع الفراغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول العالم النامية، هو في الأساس جزء من مشروع الصين لإعادة رسم الجيوسياسية الاقتصادية في العالم ومن دون ادعاءات سياسية أو حقوقية أو أخلاقية كما اعتادت البروباغندا الغربية على تمرير مشاريعها منذ عقود، خصوصاً بعد حالة التراجع والانكشاف في معالجة مناطق التوتر في العالم وطريقة الازدواجية في تناول ملفات المنطقة وفقاً لاعتبارات اقتصادية محضة.
مشروع الصين رغم نفعيته وبراغماتيته واضح وصريح يهدف إلى بناء تحالفات جيواستراتيجية لحماية الممرات البحرية الحساسة والمهمة لنقل الطاقة، وبناء منشآت عسكرية بتوافق مع الدول المستهدفة لحماية مصالحها الاقتصادية.
النفوذ الاقتصادي في عالم اليوم هو السلاح الأول المفضل للدول القوية. ولذا؛ نرى مع كل التهديدات الكبرى التي تهدد أمن الخليج ودوله، أنها - بشكل أكثر وضوحاً في السعودية ورؤيتها الاقتصادية - ماضية بقوة في إنجاز المشروعات الاقتصادية، رغم صفيح المنطقة الساخن، مع تعزيز خطوط الدفاع ومشروعات الأمن القومي والردع، من دون الانزلاق في ردود الفعل القصيرة المدى.
الريادة الصينية في مجال البنى التحتية تجلّت بوضوح في مشروعها لشبكات الجيل الخامس باستثمارات هائلة ضمن حزمة من التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الصناعي والمدن الذكية، التي تتضمن أنظمة مراقبة متكاملة وحلولاً أمنية رقمية عادة ما يتم الحديث عنها كجزء من النقد الغربي لاستراتيجيات الصين الداخلية في تقوية قبضة الحزب الحاكم... هذه التقنيات الآن تعدّ السلعة الأبرز للصين وفق مشاريع تصدير تقنيات الذكاء الصناعي التي تتجاوز تقديرات أرباحها 70 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، خصوصاً مع استهداف دول مستقرة ذات طموحات اقتصادية وأسواق مفتوحة لا تخضع لسيطرة الشركات الغربية كما هو الحال مع صربيا التي بدأت شراكة طويلة مع «هواوي» في تطوير تعاون يخص الذكاء الصناعي وبناء مدن ذكية ومراكز ابتكار وفقاً لتقرير معهد واشطن الأخير حول النفوذ الصيني في الشرق الأوسط.
على مستوى دول الخليج والسعودية، فإنها تمثل السوق الأكثر أهمية والأسرع نمواً، خصوصاً ما بعد موجات الربيع العربي ورياحها التي قوضت استقرار دول كثيرة في المنطقة. وتشير التقديرات إلى فرص هائلة بانتظار هذه الدول مع الاعتماد على تكنولوجيات الذكاء الصناعي الصاعدة؛ الأمر الذي شرعت فيه السعودية منذ تدشين «رؤية 2030» الطموحة ومخرجاتها الوطنية التي ساهمت في تجاوز تأثيرات أزمات لوجيستية كبرى، خصوصاً ما بعد جائحة «كورونا» التي قدمت فيها المملكة نموذجاً واعداً على مستوى استخدام التقنية والتكنولوجيا في تقديم الخدمات اللوجيستية عن بُعد، وقبل ذلك التحوّل الرقمي الهائل على مستوى الحوكمة، وتتطلع رغم التحديات إلى خلق أسواق اقتصادية كبرى على مستوى الذكاء الصناعي والرقمنة والريادة على مستوى الشرق الأوسط، خصوصاً في مجال البنى التحتية والخدمات اللوجيستية الذكية والطاقة المتجددة، إضافة إلى المجالات العسكرية والتسليح بخبرات توطين محلية، كما تسعى في إطار تدشين المدن والمناطق الخاصة إلى نمذجة تجربة «نيوم» الواعدة كمدينة ذكية مستدامة وعملاقة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.
على مستوى مستقبل المنطقة، فإن الرهانات لا علاقة لها بالصعود الصيني رغم التقاطعات مع ما تقدمه الصين من مبتكرات ونماذج باتت محل اهتمام كبريات دول العالم رغم المماحكة السياسية؛ وإنما على القدرة على الحياد في تقييم التحولات الجيواستراتيجية الجديدة وتقديم أولويات الاستثمار في الداخل والتقاط الفرص الواعدة في مجالات الذكاء الصناعي، وتسخير الطاقات الشبابية الهائلة التي تشكل النسبة الأعظم من السكان في التدريب، والتخلص من رهاب التخصصات التقليدية في التعليم واجتراح مجالات جديدة على مستوى المهارات والتدريب والتخصصات الدقيقة، خصوصاً في المجالات الحيوية، ومنها الصحة التي كان أحد تحديات «كورونا» في كل دول العالم، بما فيها المتقدمة تماسك مؤسساتها الصحية والخدمات المساندة لها، والأهم المضي قدماً في التطلع إلى المستقبل رغم مشاريع الاستهداف السياسي التي تقودها دول حلف الأزمات التي تحاول الزجّ بأزماتها الداخلية ومشاريعها في انتهاك السيادة في مناطق التوتر، وجرّ دول الاعتدال إليها عبر فوضى المحتوى المضلل لإعلام الظل الذي بات مصاباً بالتشنج والهلع والآيديولوجيا المفرطة التي ما عادت تلائم أزمنة التحولات الكبرى.
GMT 08:40 2025 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
جانب فخامة الرئيسGMT 06:34 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير
المصريون والأحزابGMT 04:32 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
رسائل الرياضGMT 04:28 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
د. جلال السعيد أيقونة مصريةGMT 04:22 2025 السبت ,05 إبريل / نيسان
إيران وترمب... حوار أم تصعيد؟المخاوف من عدم إستقرار قيمة الدولار تتزايد بسبب سياسة ترامب الإقتصادية
واشنطن - ماريّا طبراني
مشهد هبوط وصعود قيمة العملات النقدية العالمية أمر إعتيادي في الأسواق ، لكن ما حصل من تراجع لسعر صرف الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة كان غير عادي على الإطلاق . إذ كان سعر صرف الدولار في صعود أثناء الخ...المزيدشيرين عبدالوهاب تعود للساحة الفنية وتشيد بدراما رمضان وتبدي إعجابها بمسلسل "إخواتي"
القاهرة ـ العرب اليوم
غابت شيرين عبدالوهاب لفترة طويلة عن الظهور، بعدما شاركت في إحدى الإعلانات في شهر رمضان الماضي، وكذلك مشاركتها في إحدى حفلات عيد الفطر، وبعد فترة من الغياب، فسره البعض باهتمام الفنانة المصرية بمتابعة بعض الأعمال ا�...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©