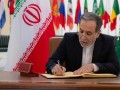الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
انتصار لبناني جديد...
انتصار لبناني جديد...

بقلم:حسام عيتاني
انتصر لبنان، إذن، وفَرَض على العدو الإسرائيلي القبول بوجهة النظر القائلة إن الخط البحري 23 هو الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة. الانتصار اللبناني ينقصه حتى الآن تفصيل صغير ليدخل لائحة الإنجازات الكبرى للعهد ورئيسه ومقاومته: أن تعترف إسرائيل به.
تثير السأم رواية تبدل مطالب لبنان الناتجة عن قلة كفاءة ممثليه ودخول الانتهازية عنصراً مقرراً لمساحة منطقته الاقتصادية ومحاولات مقايضة تأييد الموقف الأميركي للمطالب اللبنانية بمكاسب سياسية داخلية لهذا الفريق أو ذاك. سأم يُدرك المصابون به أن المسألة ستنتهي «بانتصار» آخر للمنظومة الحاكمة ولحماتها، بغض النظر عن الخط البحري الذي سيرسو عليه البازار اللبناني - الأميركي - الإسرائيلي.
فليس في جعبة من يحكم لبنان من علاج لانهيار الدولة وتفكك المجتمع وموت الاقتصاد والتعليم، سوى تسويق الأوهام والأضاليل عن انتصارات غير قابلة للصرف ولا للتحول إلى حقائق ووقائع في المستقبل المنظور. كذبة كبيرة أخرى أضيفت إلى سلسلة طويلة من نظيراتها التي يطلقها السياسيون اللبنانيون على مواطنين مكلومين وعلى استعداد للتعلق بحبال الهواء علها تخفف عنهم آلام العيش اليومي بين أنقاض ما كان وطناً.
بكلمات ثانية، يحجب حال لبنان اليوم أي قيمة لاعتماد الخط 29 الذي طالبت به السلطة اللبنانية مدة من الزمن قبل أن تتخلى عنه، أو القبول ببديله الخط 23 المائل أكثر نحو الشمال والذي يقول نقاده إنه يترك مئات الكيلومترات المربعة من المياه التي تخفي تحتها نفطاً وغازاً، لإسرائيل. تَسَاوي الخطين في القيمة بالنسبة إلى لبنان الحالي، يرتكز على انعدام قدرته على الاستفادة من أي منهما. فلا يبقى من إبلاغ الموفد الأميركي عن تمسك لبنان بالخط البحري 23 سوى زجليات البطولة الوهمية والفوز الكبير وسط الخواء واللامعنى. دورة كاملة من المواقف العدمية يسعى أصحابها إلى ستر فضيحة الوضع الذي يستندون إليه أثناء جلوسهم إلى طاولة المفاوضات.
الانتقال من مهرجان الانتصار اللفظي إلى الاستخراج العملي لما يختزنه البحر من ثروات قبالة الشواطئ اللبنانية، يتطلب أعواماً من العمل مع الشركات المتخصصة وإجراءات معقدة وتدابير ميدانية، أنجز بعضها في الأعوام الماضية لكن من دون وجود أي ضمانات بأن الغاز والنفط موجودان حقيقة في البحر، على ما دلت عليه تجربة البحث في البلوك رقم 4 سنة 2020 التي انتهت بتقرير من الشركة المنقبة يقول إن استخراج كمية الغاز الكامنة هناك، ليس ذا جدوى اقتصادية.
بيد أن «تفاصيل» وصغائر كهذه لم تردع الجماعة الحاكمة عن ابتكار المزيد من القصص الخيالية، الأكثر رواجاً من بينها تلك المتعلقة بحقل غاز طبيعي اختير له اسم «قانا» على اسم القرية الجنوبية التي يقول الإنجيل إن يسوع المسيح حقق فيها أولى معجزاته والتي ارتكبت إسرائيل فيها مجزرة دموية في 1996. ما من بحث واحد يتمتع بالجدية والمصداقية يجزم بوجود الغاز في هذا الحقل المتخيل. وليس بين المصادر المتوفرة، باستثناء بعض الخرائط التي خطها هواة على برامج «الفوتوشوب»، مما يؤكد أن ثمة غازاً قابعاً في الحقل المذكور. ويحتاج الأمر إلى معجزة كبرى لتتحول أوهام المبشرين بحقل «قانا» إلى حقائق مادية.
لكن المهم ليس وجود أو غياب النفط والغاز تحت المياه اللبنانية. المهم في عرف السلطة اللبنانية هو القدرة على بيع جلد الدب قبل صيده وإعادة بيعه إلى كل من تبدو عليه سمات البراءة والحاجة والفقر. الأمين العام لـ«حزب الله» ربط بين خلاص لبنان من نكبته الاقتصادية وبين استخراج النفط والغاز، بل حدد مبلغاً بالدولار الأميركي سيناله كل مواطن لبناني عند تدفق النفق من البحر. هذا كلام في الهواء. ذاك أن صناعة كبيرة مثل الوصول إلى المكامن البحرية واستغلال الثروة النفطية والغازية تحتاج إلى أكثر من «إطلالة تلفزيونية» وما يزيد كثيراً على بعض التغريدات المهللة للمواقف الشجاعة للرئيس ميشال عون وأصحابه ومستشاريه.
وإذا وضعنا جانباً مجموعة الشركات الوسيطة التي ستؤدي دوراً لا لزوم له بين شركات الاستخراج والتنقيب الأجنبية وبين الدولة اللبنانية، هذه الشركات التي أسستها أطراف الجماعة الحاكمة قبل أكثر من سبع سنوات وكانت جزءاً من التسوية الرئاسية التي أوصلت ميشال عون إلى قصر بعبدا، ويتلخص دورها في ضمان استيلاء الطبقة السياسية اللبنانية على الحصة الأكبر من الثروة النفطية قبل وصول ما يتبقى من فتات إلى الخزينة العامة، إذا وضعنا جانباً هذه الشركات الطفيلية، فلن نجد سوى آلية التحاصص والتناهب اللبنانية التقليدية لاستغلال هذه الثروة، بل حتى كل محاولة لإنقاذ لبنان.
فالمشكلة ليست في الخط 23 أو 29. ولم تكن يوماً كذلك. فهذه زوبعة من غبار أثارها عدد من المزايدين والمناقصين في سوق الأوهام والخيالات. بل هي في التصور اللازم لإدارة المال العام وتنظيم استثماره والجهة التي ستجني الأرباح منه: أهو مجموع اللبنانيين الذين تمثلهم دولة بحد أدنى من الفساد - أو فلنقل دولة تعاني من فساد لا يؤدي إلى شللها - وتضع فكرة المصلحة العامة كهدف أسمى لها؟ أم رهط المنتفعين الذين قادوا لبنان إلى دماره وصعدوا على تلة أنقاضه يبحثون عما تبقى مما يستحق البيع؟
الصورة اليوم لا تقول إن اللبنانيين، بعمومهم وبمن يمثلهم من قوى التغيير بعد تكريس الانتخابات النيابية الأخيرة للتقاسم المعهود، وبموازين القوى الاجتماعية والسياسية، ليسوا بقادرين على استرجاع ثرواتهم ولا على تنظيم شؤونهم خارج عملية تقاسم الغنائم والأنفال المرعية الإجراء منذ عقود. أما الكلام عن ثروات في البحر سيأتي استخراجها بالرفاه والبحبوحة، فمجرد مزاح سمج مثل أهله.
GMT 06:23 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
المبحرونGMT 06:20 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
قرارات أميركا العسكرية يأخذها مدنيون!GMT 06:17 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
تسالي الكلام ومكسّرات الحكيGMT 06:14 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
كيف ينجح مؤتمر القاهرة السوداني؟GMT 06:11 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
اكتشافات أثرية مهمة بموقع ضرية في السعوديةبعد أن أصبح الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين تراجعه ناجم عن جني أرباح من المستثمرين
لندن - ماريّا طبراني
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا يوم الأربعاء، بلغت 3300 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار أمريكي للأونصة، مع استمرار بحث المستث...المزيدصابرين تكشف أسرار رحلتها الفنية من الغناء إلى التمثيل وتأثير الكبار في تشكيل ملامح مشوارها
القاهرة - العرب اليوم
خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير ضمن سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد "شمّ النسيم"، فتحت الفنانة صابرين قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مشوارها الفني، وتجاربها الإنسانية، وندمها الوحيد، وت...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©