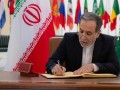الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
50 سنة من الخيبات
50 سنة من الخيبات

سام منسى
بقلم - سام منسى
أي عاقل يصدق أن الأزمة اللبنانية تُحل بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية؟ مرة جديدة، تؤكد مواقف القادة المسيحيين في لبنان المؤكَّد، وتدحض سمة التحامل ممن يتهمون المسيحية السياسية أنها تتقن فن الانتحار. ونتحدث هنا عن حالة المسيحية السياسية، وليس عن المواطنين المسيحيين، وهم لا حول لهم ولا قوة، ومسؤوليتهم الوحيدة هي أنهم إما غير راغبين وإما غير قادرين على الخروج من سطوة زعمائهم، والأسباب كثيرة ومتنوعة، وللأمانة أيضاً، ولا نتجنى نخص منهم القادة الموارنة. التركيز إذن على أداء القادة المسيحيين من دون تبرئة أو تنزيه السياسيين من الطوائف الأخرى، إنما يتحمل القادة المسيحيون مسؤولية كبرى؛ كونهم يعتبرون عن حق أو غير حق أن كيان لبنان منتوج مسيحي نضالاً وفكرة.
نقول هذا لصعوبة تصديق الدرك الذي بلغه سوء أدائهم السياسي، والمتراكم على مدى عقود وفي الحد الأدنى منذ السبعينات، فتراهم ينتهجون في عناد عبثي السياسة نفسها، ويقعون في الأخطاء نفسها، ويتمتعون بشبه مناعة ضد التعلم من هذه الأخطاء ومن الدروس المستقاة من مسار الأحداث، الداخلية منها والإقليمية.
الخطأ بدأ مع توقيع اتفاق القاهرة سنة 1969 مع منظمة التحرير الفلسطينية بموافقتهم، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بينهم وبين المنظمات الفلسطينية لتصل إلى حرب أهلية مدمرة. مهما كانت الأسباب وجيهة، الحرب ضد الوجود الفلسطيني في لبنان لم تكن مهمة المسيحيين وحدهم.
وفي عام 1990، تاريخ الانتهاء المفترض للحرب الأهلية، ومع محطات باهتة من الاستقرار الوهمي تحت السيطرة السورية، ومع انتهاج سياسات بهلوانية تفتقت عنها الشطارة اللبنانية بمفهومها المركنتيلي، ومع غلبة الانتماءات الفرعية عند البعض والفرعية - الخارجية عند البعض الآخر ومن كل الطوائف على الانتماء الوطني، ومع إتقان فن التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة والتحايل على الدستور ودك علاقات البلاد مع محيطها الطبيعي العربي كما مع امتدادها المتوسطي الغربي. واصلت الأزمة اللبنانية مسارها الانحداري لتصل إلى قعر الهاوية، وليضاف إلى تسمياتها بالأزمة السياسية والاقتصادية والمالية تسمية الأزمة الأخلاقية بامتياز؛ لأنه حتى مع إقرار جميع الأطراف، باستثناء «حزب الله»، بأن البلاد تمر بأزمة وجودية تهدد الكيان برمته، ما زال الأداء ينم عن ضيق الأفق وتغليب المصالح الشخصية على العامة وعن خفة واستهتار وتهاون يرتقي إلى التفريط فيما تبقى من هذا الوطن. وبين سنة 2005 و2008 يتحمل جزء من القادة المسيحيين إجهاض «حركة 14 آذار»، أهم حراك سياسي موحد للبنانيين في تاريخه الحديث.
بالعودة إلى الزعامات المسيحية بأطيافها كافة، وبالاستناد إلى التطورات الأخيرة التي أعقبت انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وما تلاها من جلسات صوريّة لانتخاب رئيس للجمهورية، والمواقف الصادرة عنهم إثر دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، نستطيع القول إنهم ما زالوا يحنّون إلى السياسات التي أوصلتهم أوائل سبعينات القرن الماضي إلى الانتحار، ولذلك مؤشرات عدة.
أولاً: ما زال الهم الأكبر لدى الزعامات المسيحية هي «حقوق المسيحيين» وليس بناء الدولة الوطنية الحداثية، وتتجسد هذه الحقوق عندهم للأسف بـ«كرسي بعبدا» مهما كان هوى الجالس عليه، في موقف يدل على أن الانتماء إلى الطائفة لديهم يغلب الانتماء إلى الوطن. ولا يقتصر هذا الموقف على طرف واحد بحيث بينت الوقائع الأخيرة أن «التيار» و«القوات» و«الكتائب» وغيرهم من الناشطين المستقلين المسيحيين يؤمنون بحتمية بقاء الرئاسة الأولى للموارنة.
ماذا لو قدّر للرئيس أمين الجميل تسليم الحكم بعده كما يقتضي الدستور إلى الحكومة اللبنانية التي كانت آنذاك برئاسة الرئيس السني سليم الحص عوض حكومة عسكرية انتقالية بقيادة المسيحي ميشال عون؟ وماذا لو لم يرفض البطريرك الراحل نصر الله صفير المطالبة باستقالة الرئيس إميل لحود إبان ثورة الأرز عام 2005، وهو الحجر الأساس في تثبيت السطوة السورية على البلاد؟ وماذا لو لم يعارض البطريرك الماروني بشارة الراعي عقد جلسة لمجلس الوزراء بذريعة أن هكذا اجتماع يدق إسفيناً في صلاحيات رئيس الدولة المسيحي، ويطلق مع المفتي عبد اللطيف دريان ميثاقاً إنقاذياً من خارج الصندوق؟ وماذا لو لم يبارك قائد القوات اللبنانية انتخاب خصمه اللدود عون؟ طبعاً لما كنا في هذا الجحيم. ومع الأسف، سمعنا بمطالبة بعض زعماء الموارنة «السياديين المعارضين» قواعدهم الشعبية بعدم الاحتفال بانتهاء ولاية الرئيس عون؛ لأن في ذلك مساً للموقع الماروني الأول! وللتذكير، أخذ عون في مطلع التسعينات المسيحيين واللبنانيين جميعاً إلى حربين مدمرتين؛ الأولى مزقت النسيج المسيحي وأدت إلى هجرة أعداد هائلة منهم عدا عن الذين قتلوا ودمرت أرزاقهم، والثانية أخضعت لبنان للوصاية السورية. وبعد ثلاثين عاماً، وخلال ولايته الرئاسية، كرّس الهيمنة الإيرانية وتسبب في حرب ثالثة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه وتداعياتها أخطر على المسيحيين من حربي الإلغاء والتحرير.
ثانياً، من أجل هذا «الكرسي»، تراهم مستعدين للتحالف مع الشيطان. فإبان الحرب الأهلية تحالفوا تارة مع حافظ الأسد، وطوراً مع إسرائيل، وانتهت بهم الأمور مع اتفاق الطائف إلى خسارة نصف سلطتهم من دون أن يربحوا الوطن. وبعد الطائف، تحالف الانتهازيون والوصوليون منهم مع النظام السوري الاستبدادي المحتل الذي أعاث بالبلد فساداً، لينقلوا بندقية التحالف بعد خروجه من لبنان إلى الذراع الإيرانية ويمنحها غطاء مسيحياً مكّن إيران من التفاخر بالسيطرة على أربع عواصم عربية ضمنها بيروت. وبدأت بعد ذلك شيطنة الطائفة السنية وربطها بالإرهاب التكفيري عبر شيطنة الحريرية السياسية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وشنت حرب عشواء ضدها وعلى مدها العربي، ونجحوا في تفكيك الطائفة محدثين فراغاً لم تتمكن أي من الشخصيات السياسية منها من ملئها.
ثالثاً، الإصابة بلوثة اختطاف الطائفة والانتقاص من تمثيلها. ما يقال عن حقوق المسيحيين هو في الواقع مصالح الطرف القيادي الماروني الذي يصل إلى السلطة. فكما عند «حزب الله» ليس كل شيعي «شيعياً»، فعند المسيحيين أيضاً ليس كل مسيحي «مسيحياً»، وليس كل ماروني «مارونياً». حقوق المسيحيين عند ذاك الطرف هي حقوق المسيحيين الموالين له. بالنسبة إلى جبران باسيل صاحب شعار «حقوق المسيحيين»، الحصول عليها يعني حصول الموالين له فقط دون غيرهم على المكاسب. ومع تجربة الرئيس عون وصهره باسيل، تحضر بقوة ثنائية «بشارة وسليم الخوري»، بغض النظر عن الاختلاف بين شخصيتي الرئيسين.
رابعاً، عجز الطائفة المارونية عن استيلاد النخب الاعتدالية التي تتلاقى مع الاعتداليين من شركائها في الوطن. كان الصحافي الراحل ميشال أبو جودة يطلق على الرئيس تقي الدين الصلح اسم «تقي بك السني المسيحي»، في إشارة إلى المعتدلين من المسلمين الذين يتلاقون ثقافياً وحضارياً مع المعتدلين من المسيحيين عموماً والموارنة بخاصة. فهل اليوم بين زعماء الموارنة من نطلق عليه اسم «شربل بك المسيحي المسلم»؟
في الخلاصة، نعود إلى «نخبنا» ونستذكر مجدداً ميشال أبو جودة، عندما قال: «إن خطأ الموارنة القاتل أنهم أسسوا كياناً وضعوه في خدمة الرئاسة وليس العكس، فقدموها عليه وفشلوا في بنائه كوطن، والخوف من أن يخسروا لاحقاً الاثنين معاً». والشيء بالشيء يذكر، نمر على قول الراحل منح الصلح أن «الشيعي حسين الحسيني هو آخر ماروني في لبنان» عندما أصر على المناصفة الميثاقية في اتفاق الطائف في مسعى «لوقف العد»، وتبناها الرئيسان الحريري الأب والابن؛ إيماناً بأهمية الوجود المسيحي في لبنان. لعل في الاستذكار ما ينفع.
أيا ترى، هل حان أوان تغيير هذا النهج لمغادرة النفق؟ هل حان أوان ترك المنطقة الرمادية بالخروج من الملعب الذي رسم حدوده «حزب الله»؟ أو الاستسلام والشروع بتسوية وفق شروطه؟
GMT 13:05 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
حزب الله بخيرGMT 11:57 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مرحلة دفاع «الدويلة اللبنانيّة» عن «دولة حزب الله»GMT 11:55 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
هل هذا كل ما يملكه حزب الله ؟؟؟!GMT 20:31 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
عشر سنوات على الكيان الحوثي - الإيراني في اليمنGMT 20:13 2024 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
صدمات انتخابيةمحمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأحلام تطلق ألبومها الجديد "العناق الأخير" وتعرض مفاجآت تعكس عصارة 30 عامًا من الإبداع الفني
أبوظبي - العرب اليوم
الفنانة أحلام أفرجت أخيراً عن أغاني ألبومها الجديد "العناق الأخير"، وذلك بعد فترة من الترويج للألبوم وبعد فترة من تشويق الجمهور إليه، وكشفت الفنانة أحلام عن مفاجآت غير متوقعة في ألبومها الجديد والذي تفتتح به �...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©