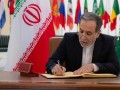الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
«طوفان السلام»
«طوفان السلام»

بقلم - سام منسى
بعد شهر على عملية «طوفان الأقصى»، بات ممكناً القول إن الهدف منها تجاوز اختراق أمن وغطرسة إسرائيل وهيبة جيشها الذي لا يقهر، ويخطئ من يستهين بالنتائج السياسية التي حصدتها الجهات المنفذة والمخططة والراعية، سواء كانت «حماس» بمفردها أو محور الممانعة مجتمعاً. بناء على عقيدة وقناعات وأهداف هذا المحور، يبدو أنه حقق إنجازاً سياسياً مميزاً، رغم كل الفظائع بحق المدنيين سواء التي ارتكبتها «حماس»، أو استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضدهم بما يتعذر وصفه. إسرائيل بحكومتها الحاضرة وعلى الرغم من انضمام أحد ركني المعارضة إلى المجلس الحكومي المصغر، ستجد نفسها في مأزق. ولاستباق من يرد أن ما يجري في غزة قد يقضي على حركة «حماس» أو ينهكها ويحد من دورها، نجيب ماذا بعد القضاء على «حماس» على افتراض أنه ممكن؟
يصعب أن يكون لاستمرار آلة القتل من دون أفق سياسي واضح سوى اجتثاث «حماس» النتائج المرجوة، ومخاطره لا تتلاءم مع ما تصبو إليه إسرائيل من الحفاظ على أمنها وأمان شعبها. جولة سريعة على ردود الفعل المحتجة على مقتل المدنيين في غزة بالدول الداعمة لإسرائيل تظهر تصاعدها، وقد تجبر هذه الدول على التراجع عن دعمها المطلق لتل أبيب. بدأت ملامح انكماش هذا الدعم تظهر بالإجماع الدولي على فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة، إلى المبادرات الدبلوماسية المطالبة بهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار إلى المعزوفة المعهودة بعد كل عملية عسكرية تؤدي إلى إزهاق أرواح المدنيين، فكيف إذا بلغت حصيلتها آلاف القتلى والجرحى في غضون أسابيع قليلة؟ وتظهر أيضاً في تصويت 120 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بينها 8 دول أوروبية، ومطالبة حكومات آيرلندا وإسبانيا علناً باعتبار ما يحدث في غزة جرائم حرب.
إلى ذلك، قد يؤدي استمرار عنف إسرائيل المفرط إلى مزيد من الضغوط الشعبية في بعض الدول العربية. أول الغيث كان الأردن الذي جمّد علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، وتبعته البحرين.
وليس مستبعداً إذا تفاقم سوء الأوضاع في غزة عسكرياً وأمنياً وإنسانياً، أن تفتح جبهات جديدة من لبنان وسوريا وبدعم الميليشيات التي تدور في فلك طهران في العراق واليمن، بالرغم مما حمله خطاب السيد حسن نصر الله الأخير من التباسات إيرانية حول فلسطينية الصراع واعتبار جنوب لبنان جبهة مساندة.
في الواقع، أظهرت عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) أنَّ الصراع بين معسكري السلام والممانعة في المنطقة يتجاوز فلسطين والفلسطينيين، ليسعّر الصراع الحضاري بين الغرب والعالم الإسلامي، عبر الاستفادة من المآسي التي تحصل لتوسيع رقعة القوى المضادة للنفوذ الغربي، إضافة إلى زعزعة كل سياسات معسكر الاعتدال العربي الهادفة إلى السلام وتجفيف النزاعات والتنمية الاقتصادية والانفتاح والاسترخاء في العلاقات الدولية، وجر معسكر السلام إلى حيث لا يريد. جوهر الصراع هو رغبة محور الممانعة في السيطرة والغلبة والهيمنة في الإقليم ونشر مبادئه وعقيدته وأفكاره عبر تغيير أنماط العيش وتديين السياسة والاجتماع وشؤون الحياة كافة. سبتمبر (أيلول) الأميركي حمّل العالم الإسلامي مسؤولية إرهاب «القاعدة»، وأكتوبر الإسرائيلي حمّل الفلسطينيين مسؤولية عملية «حماس». أربعة أسابيع من هذه الحرب الانتقامية، بعثت في العالم العربي شعارات ومقولات عتيقة تحث على المقاومة، وتشحن النفوس بأجواء الحرب والشهادة، ونادرة العواصم العربية التي لم تشهد مثل هذه الأجواء. الأخطر أن مبادئ وأفكار هذا المحور تتماهى مع اليمين الإسرائيلي المتشدد، ما يجعل الحلول مستعصية ولا تتجاوز التسويات المؤقتة، وهي ولّادة لحروب ومآسٍ جديدة بشكل دوري ضحيتها الرئيسية المدنيون.
المخارج المتداولة غالبيتها مكررة وتقع في رتابة الدبلوماسية وأنصاف الحلول. الجميع يتكلم عن حل الدولتين، إنما العقبة الرئيسية أمامه تكمن في أن المعنيين به مباشرة، هم المعرقلون له: «حماس» التي تريد اقتلاع إسرائيل، واليمين الإسرائيلي لا يرى إلا طرد الفلسطينيين من أرضهم واحتلالها.
لن تتوقف المآسي والمجازر والمخاطر السياسية والأمنية جراء الانقلاب المتأتي عن «طوفان الأقصى» إلا بعمل يفوق ذلك أهمية ويشكل اختراقاً غير مسبوق، ويطلق عليه تسمية «طوفان السلام»، يقتحم الحواجز والعوائق التي تمنع الاعتدال في إسرائيل من الإقدام الجدي الثابت على الاعتراف بأن لا سلام سوى بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضي فلسطين. الاختراق المطلوب ركائزه معروفة: العقلاء في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. أما محرك هؤلاء فهو رافعة عربية، وهي المعنية مباشرة بهذه التسوية التاريخية.
المقصود بالرافعة العربية هي دول: السعودية ومصر والإمارات والأردن، التي تقع عليها مسؤولية اجتراع مبادرة من خارج السياق المتداول تتجاوز المبادرة العربية واتفاق أوسلو وصفقة القرن، يحملها معاً قادة هذه الدول إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، وبعدها ربما إلى القدس نفسها مع الأميركيين وبدعمهم، وهم المحتاجون لمثل هذه الخطوة الخلاقة التي تضع الإسرائيليين أمام وقائع جديدة، وتخرجهم من جحيم استمرار آلة القتل والدوران في الحلقة المفرغة، وتقدم إطاراً واضحاً لمسار تفاوضي خواتيمه إقامة دولتين.
البعض يقول إن الوقت غير مناسب قبل أن تبرد النفوس والعواطف، بينما البعض الآخر يرى أنه الوقت الأكثر ملاءمة؛ لأن من شأن هذه الخطوة إنقاذ المدنيين الأبرياء من هذا الجحيم، والاستفادة من الزخم الدولي الساعي إلى حل سياسي، والأهم انتزاع ورقة فلسطين من يد إيران، وهي بمثابة حصان طروادة تنقله طهران في كل مرة إلى حيث تشاء.
يبقى عامل التوقيت، إذ ينبغي أن يسبق هذه الخطوة تشكيل حكومة إسرائيلية تستبعد أولاً بنيامين نتنياهو وزعماء اليمين المتشدد، كونهم ألغاماً في طريق أي عملية سلام، وكل استطلاعات الرأي في إسرائيل تحمّل هذه الحكومة مسؤولية ما جرى وتدعوها إلى الاستقالة، والدول الداعمة لإسرائيل تنتظر هذه الخطوة وترحب بها. إلى عامل التوقيت، يبقى عامل الشجاعة، ودونه لن تُكسر حلقة الرتابة وتكرار المجرّب، مع أهمية الاستفادة من المحاولات الدبلوماسية وتجييرها لصالح «طوفان السلام» المنشود.
طبعاً أصحاب الممانعة والرفض والمقاومة لن يتبخروا، إنما تسوية عقلانية واقعية وعادلة للقضية الفلسطينية تُشكل تطوراً غير مسبوق سيقلب المعادلات في المنطقة، والمؤكد أن ذلك سيضعف محور إيران وحلفائها داخل الإقليم وخارجه.
GMT 20:40 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
عندما يعلو صوت الإبداع تخفت أصوات «الحناجرة»GMT 06:23 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
المبحرونGMT 06:20 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
قرارات أميركا العسكرية يأخذها مدنيون!GMT 06:17 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
تسالي الكلام ومكسّرات الحكيGMT 06:14 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
كيف ينجح مؤتمر القاهرة السوداني؟محمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأصالة تحتفل بفوزها بجائزة "جوي أوورد" للعام الثاني وتستعد لإهداء الجمهور أغنية جديدة "ممنوع"
الرياض ـ العرب اليوم
الفنانة أصالة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" بعدما فازت بجائزة المغنية المفضلة للعام الثاني على التوالي، وعاشت الفنانة أصالة عام مليء بالإنجازات والأعمال الفنية المتنوعة والتي جعلتها تستحق الفو�...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدالتطورات التكنولوجية في مجال زراعة الأسنان الرقمية ودورها في تحسين الرعاية الصحية للفم
القاهرة ـ العرب اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©