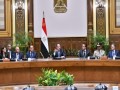الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
أميركا ومخاطرة «الإجراء الوازن»
أميركا ومخاطرة «الإجراء الوازن»

بقلم - فهد سليمان الشقيران
في جميع شهادات قيادات تنظيم «القاعدة» ممن شاركوا في التخطيط لأحداث 11 سبتمبر (أيلول) يقرّون بهدف العملية الأساسي: «ضرب العلاقة السعودية الأميركية». الدعم الإيراني لـ«القاعدة» بهذه العملية كان الغرض منه دقّ الأسافين في العلاقة التاريخية بين البلدين. بُنيت هذه العلاقة على أسس راسخة أساسها المصالح العميقة المشتركة وذلك ضمن ظروف محددة فرضتها توازنات القوى في المنطقة آنذاك، لاحقاً وجدت أميركا بالسعودية حليفاً موثوقاً لديه قدرته على لعب أدواره القيادية في المنطقة ومن هنا التقت المصالح بشكلٍ كبير. نبتت دول مارقة تكنّ العداء للقيم التي تعتنقها السعودية وهي مشتركة مع القيم الأميركية، تلك العلاقة يراد لها أن تُفضّ بطرقٍ ورسائل مختلفة بمحاولاتٍ عديدة منذ 2001 وحتى اليوم.
تبدو أسابيع الرئيس بايدن الماضية منسجمة مع سياسة أوباما الذي يرى السعوديين مثل «راكب القطار المجاني» كما في حديثه الشهير لصحيفة «ذا أتلانتيك»، وهي سياسة تعدّ إيران شريكة في إدارة ملفات المنطقة. لأوباما مقولته: «على السعوديين والإيرانيين تعلم تقاسم المنطقة»، فإيران هنا ليست داعمة للفوضى بل - حسب نظرية أوباما - فإن الصراع بين السعودية وإيران هو الذي خلق الفوضى في الدول العربية! لم يرَ أوباما ولو لمرة أن إيران إرهابية بسبب استهداف مئات الأميركيين في لبنان وسوريا والعراق، ولم يؤمن بوجود عقيدة فوضوية لدى النظام الإيراني، ولم ينصت إلى مستشاريه حين نصحوه بأخذ إجراءات حازمة تجاه إيران، ذلك أن الاتفاق النووي سيقوّي من نفوذها في مناطق نفوذ الولايات المتحدة وسيجعل الفوضى تعمّ المنطقة ومصالح الولايات المتحدة تحت مرمى نيران الصواريخ الإيرانية الإرهابية.
بعد الاتفاق النووي كتب الأمير بندر بن سلطان مقالة بعنوان: «طبق الأصل ثانية»، ومما أكده الأمير الخبير أن «الرئيس أوباما اتخذ قراره بالمضي قدماً في الصفقة النووية مع إيران وهو مدركٌ تمام الإدراك أن التحليل الاستراتيجي لسياسته الخارجية، والمعلومات الاستخبارية المحلية وتلك الآتية من استخبارات حلفاء أميركا في المنطقة لم تتنبأ جميعها بالتوصل إلى نتيجة الاتفاق النووي نفسها مع كوريا الشمالية فحسب، بل تنبأت بما هو أسوأ، إلى جانب حصول إيران على مليارات من الدولارات. فالفوضى ستسود الشرق الأوسط، الذي تعيش دوله حالة من عدم الاستقرار، تلعب فيها إيران دوراً أساسياً».
بعد سنوات من تحليل الأمير بندر بدأت تُطرح في بعض مراكز الدراسات الأميركية نظرية «وزن العلاقة مع السعودية»، حجة أصحابها أن الذي يجمع السعودية مع أميركا أمران؛ النفط، ومحاربة الأعداء في المنطقة، الأول بدأ يفقد قيمته بالنسبة إلى الأميركيين، والآخر منقوض بمِلل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، التعاون معها في ملف الإرهاب بالنسبة إلى بايدن لا يشمل الإرهاب الإيراني حتى الآن، على عكس سلفه ترمب الذي تعاون معها في ملف الإرهاب ومنه الإرهاب الإيراني. تبدو الصورة اليوم أكثر قتامة لأن السياسة الأميركية لا ترى إيران راعية الإرهاب في العالم بل تحاول التفاوض معها، هنا تعود سياسة بايدن لمربع أوباما أن لإيران حصتها في المنطقة!
لنتفحص هذه النظرية بشكل مكثف أعود لما كتبه كل من دينس روس، وروبرت ساتلوف، في مادة نُشرت في «معهد واشنطن» بعنوان «خطوة موازِنة: على بايدن إعادة تعريف العلاقات الأميركية السعودية»، ومما أورداه أن «الرئيس بايدن محقّ في التأكيد على التوازن في العلاقة»، لكنهما يعترفان بأن «واشنطن لا تزال لديها مصالح فعلية في السعودية، حيث ليست هناك مشكلة مهمة في الشرق الأوسط يمكن فيها تطبيق استراتيجية ناجحة إلا بدعم فاعل من الرياض. فمن احتواء إيران إلى محاربة الإرهاب، وإلى البناء على التطبيع العربي مع إسرائيل (واستخدام ذلك لكسر الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين) أو محاولة إنهاء الصراعات في اليمن وسوريا أو تقليلها، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعاون سعودي. علاوة على ذلك، إن إدارة عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة تستوجب أسعار نفط مستقرة وقابلة للتوقع تجعل البدائل، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين، تنافسية من حيث التكلفة - مع منع الانهيار المفاجئ لصناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة. وهنا أيضاً يُعد السعوديون مهمين».
تعليق وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو على نشر التقرير الاستخباري كان واضحاً، الهدف من نشره كان وسيظل «سياسياً» الغرض هزّ العلاقة مع السعودية إلى أقصى درجاتها، يسمّيها دينس روس وساتلوف «وزن العلاقة»، وبومبيو يعدها مخاطرة كبيرة.
والواقع أن نشر التقرير على علّاته وكوارثه وضعفه يطرح تحدياتٍ كبرى عن شكل العلاقة المأمول بين السعودية وإدارة بايدن.
يؤكد ذلك تحليل الأمير بندر بن سلطان في تصريحه بعد نشر التقرير: «كلّ استثمار فيها - قضية التقرير - هو استثمار سياسي، يتم وفق حاجات أو مواقف سياسية، وهذا أمر لم ولن يكون غريباً عن العلاقات الدولية، وكلّ دولة تتفاعل معه وفق مصالحها السياسية والأمنية والدبلوماسية، هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي آلمت كلّ السعوديين. أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فجلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالباً وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامة، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها».
التوجس السعودي من السلوك الأميركي ليس وليد اليوم. أذكّر بمقولة هنري كيسنجر: «السعوديون لديهم ثقة أقل بحكمنا على الأشياء»، ولكنه يستدرك بأن «الدبلوماسية السعودية بقيت مساعداً رئيسياً للسياسة الأميركية».
بالنسبة إلينا، نحن السعوديين، فإن الأمير محمد بن سلمان «عطية إلهية» و«هبة الله لعباده»، لقد جعل المجتمع رغم الهزات الاقتصادية والجوائح واضطراب الأسواق في مراتب عليا في التصنيفات والأرقام العالمية والدولية، وأعاد الأمور إلى نصابها في مناحي الحياة كافة، وحين يتواطأ الأضداد من تياراتٍ ومشارب مختلفة لغرض الضخ في التقرير الواهي لهدفٍ سياسي محض، فإن التكاتف مع الأمير ومشروعه سيكون أقوى من أي وقتٍ مضى، إنه النور الساطع بعد ليل الخراب الطويل.
GMT 03:41 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
ثلثا ميركل... ثلث ثاتشرGMT 03:35 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
مجلس التعاون ودوره الاصليGMT 03:32 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
عندما لمسنا الشمسGMT 03:27 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
ثلاثيّ العجز عن سيطرة العقل في لبنان: «كورونا» والدولار و«حزب الله»GMT 03:18 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
رسالة إلى دولة الرئيس بريبوتين يلوح بإمكانية وقف توريد الغاز الروسي للأسواق الأوروبية فورًا
موسكو - العرب اليوم
لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية توقف روسيا عن توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى. وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها &...المزيدمنافسة باردة بين محمد سامي وعمرو سعد بعد نجاح مسلسل الست موناليزا
القاهرة ـ العرب اليوم
يشهد سباق الدراما الرمضاني منافسة من نوع آخر، وحربا باردة بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد، بسبب التنافس على لقب الأعلى مشاهدة في رمضان. محمد سامي الذي يغيب عن الموسم هذا العام، تتواجد زوجته الفنانة مي عمر، من...المزيدميتا تخفف قيودها على روبوتات الدردشة في واتساب
واشنطن ـ العرب اليوم
في محاولة لتفادي فتح تحقيق واسع من قبل المفوضية الأوروبية، أعلنت شركة “ميتا”، أنها ستسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بتقديم روبوتات الدردشة الخاصة بها عبر تطبيق واتساب باستخدام الواجهة الخاصة بتطبيق واتساب WhatsAp...المزيداستقالة مديرة متحف اللوفر على خلفية حادثة سرقة جواهر التاج البريطاني
باريس ـ العرب اليوم
استقالت مديرة متحف اللوفر الشهير في باريس، الثلاثاء، على خلفية سرقة جواهر التاج البريطاني التي بلغت قيمتها 88 مليون يورو (100 مليون دولار) العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "سرقة القرن". وأعلن الرئيس الفرنسي إي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©