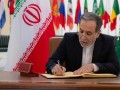الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
علامة فارقة في الزمن الجميل
علامة فارقة في الزمن الجميل

طلال سلمان
ليس كمثله أحد. هو المفرد، لغة وسلوكاً، وعياً وإحاطة وتحسساً بروح الأمة. لا ولاء لزعيم أو قائد، لا شهادة مفتوحة لأحد... ثم ذلك الظرف الساخر والتورية والجناس والطباق، وسائر فنون الكتابة المميزة والتي لا يمكن طمس هوية صاحبها بغض النظر عن كاتبها.
«البيك». له وحده لا يعني اللقب تمييزاً أو تكريماً، لذلك لا ضرورة لأن تشفعه باسم.. الكل سيعرف أنك تقصد منح الصلح ولا أحد غيره، من البكوات الذين ورثوا لقب الوجاهة وعاشوا به.
إنه «الجامعة» التي تخرّج منها وعلى كتاباته كثير من مشاهير الكتاب في الصحافة في مختلف فنون الكتابة، سياسة وثقافة وتاريخاً وعلم اجتماع وصولاً إلى شيء من الرسم والنحت عبر مبدعيه.
تخرَّج من الجامعة الأميركية ولم يخرج منها بل هو أضاف إليها «مطعم فيصل» الذي حوّله إلى منتدى حوار عربي مفتوح لمناقشة مختلف القضايا المطروحة في زمن النهوض العربي بالثورة، بأحزابه القومية ولا سيما البعث منها بقيادته التاريخية في سوريا وامتداداته إلى العراق بالذات ولبنان بطبيعة الحال، وبعضهم في موقع «الصديق» والبعض الآخر في موقع «الدارس» أو «المتلقي» ولا نقاش.
أما في الصحافة فتاريخه حافل وغني جداً، إذ قاربها مبكراً جداً مع جريدة «النداء» جريدة حزب النداء القومي لأصحابه كاظم وتقي الدين الصلح وبعض أصدقائهما في أواخر الثلاثينيات، عاش معها وفيها من دون أن يتخذها مهنة على امتداد ستين سنة أو يزيد، كاتباً متنقلاً بين الصحف والمجلات، بحسب قربها من رأيه أو بُعدها عنه.. وهو كتب ما يملأ مجلدات، ودائماً بغير توقيع، لكن أسلوبه كان يدل عليه و«يكشف» صاحب التوقيع، حتى لقد شاع تعبير «كتب البيك اليوم بقلم فلان...». على أنه ظل يكتب افتتاحية مجلة «الحوادث» حتى توقفها عن الصدور قبل سنوات قليلة، ودائماً من دون توقيعه. الأسلوب هو الرجل.
وفي «الحوادث» وأنا أدخلها، محرراً تحت التمرين، عرفت «البيك» عن قرب، فبهرتني ثقافته العامة ومعارفه وصداقاته عابرة الحدود في ما بين المحيط والخليج، مع إطلالات على الدنيا الجديدة وأوروبا القديمة.
ولقد كان في طليعة أسباب القفز بـ«الحوادث» إلى صدارة الصف الأول من المجلات، وكان يكتب ويستكتب في مجمل صفحاتها: مع سليم اللوزي وله، مع شفيق الحوت، مع نبيل خوري، وربما حاول مع محرر الفنون وجيه رضوان. وقرّبني منه إعجابه برغبتي في التعلّم وتمنّعي عن الكتابة معه. ولكنه كان، في كل أسبوع، يطل عليّ ليبدي ملاحظاته على كتاباتي الأولى.
على أن مشافهاته كانت أمتع من كتاباته، خصوصاً أنه يبدأ تقويمه لمن يطرح اسمه بإظهار الحسنات ويصمت قليلاً قبل أن «ولكن..» أو «إنما» وتكر السلبيات أو التحفظات التي تفجّر الضحك ولا يستطيع المعني بها أن يرفضها، وقد يضحك مع الضاحكين لتوليد تمتعه بالروح الرياضية.
في التاريخ علامة، وفي أنساب العائلات العريقة مرجعية تمتد من أدنى المشرق إلى أقصى المغرب.. وهو لا ينطق عن الهوى، وإنما عن معرفة مباشرة بالقراءة أو بفائض الزيارات الميدانية. عاشق لدمشق، محب لحمص، مدنف بحب حلب... أما مهوى فؤاده فعنجر التي كانت بين أملاك جده العثماني قبل أن يصادرها الانتداب الفرنسي ليجعلها أرض لجوء للأرمن المهجرين من تركيا.
أما السياسة فكان يمارسها شفهياً، وفي محلياتها هو داعية لعمه تقي الدين. وبرغم إغراءات الأصدقاء والراغبين في توريطه فقد رشح نفسه مرة واحدة للانتخابات النيابية في بيروت، وخرج من التجربة نادماً وقد تيقن أن مثله لا يتقن هذه «اللعبة».
ولقد صك منح الصلح مجموعات من الشعارات والمقولات التي لخصت رأيه وموقفه من النظام اللبناني... فهو مَن ابتدع تعبير «المارونية السياسية» التي تتجاوز الطائفة المارونية لتصيب المنهج السياسي لمختلف الزعامات السياسية التي رآها «شركة مساهمة» بين منتسبيها زعامات السنة والشيعة فضلاً عن السباقين الدروز.
وبرغم إيمانه بالعروبة فقد كان يعرف أن «عروبة» لبنان من طبيعة مختلفة، فلبنان داعية للعروبة، ولكنه ليس في «دولتها» إذا ما قامت، من هنا تركزت كتاباته على العروبة خارج لبنان، فكتب عنها في سوريا وفي العراق وفي اليمن، في مصر وشمال أفريقيا وصولاً إلى المغرب، في فلسطين طبعاً التي كان يعرف قادة نضالها الوطني في مواجهة المشروع الإسرائيلي قبل اكتماله، ثم نجاحه في إقامة دولته على أرض أهلها الفلسطينيين، في ظل العجز العربي وانحراف أهل السلطة. وكان يؤمن بدور مميز لمصر كطليعة للوطن العربي بفضل رسوخ دولتها. وبرغم إعجابه بجمال عبد الناصر إلا أنه ظل يجنح إلى البعث، ربما لأنه كان يرى فيه حركة شعبية فضلاً عن الصداقة التي جمعته بالعديد من قيادييه، فضلاً عن عدم تعلقه بالعسكر عموماً.
ولأنه كان يرى للبنان دوراً مميزاً فكان ضد إحراج النظام اللبناني بالعروبة حتى إخراجه منها إلى «رحاب» الطوائفية المعادية للوطنية.
ولقد تحمّس لانتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، بعد الثورة على الرئيس كميل شمعون ونزول قوات المارينز الأميركية على شواطئ بيروت، كرّد على ثورة 14 تموز 1958 في العراق التي كانت ـ في لحظتها ـ تمثل احتمالاً بانضمام العراق إلى دولة الوحدة التي قامت باندماج سوريا في مصر تحت قيادة جمال عبد الناصر في الجمهورية العربية المتحدة.
ولقد كان صاحب رأي، خطي وشفوي، عند الرئيس شهاب، سواء بصحبة عمه تقي الدين، أو منفرداً.. وفي عهده فقط قبل أن يشغل «موقعاً» مبتدعاً في وزارة الإعلام، هو أقرب إلى المستشار منه إلى «الموظف» في الإدارة.
مع تفجر الثورة الفلسطينية في أواسط الستينيات كان منح الصلح قريباً من قياداتها ينصح وينبّه ويحذر من التورط في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي.. ولقد كتب مقالات و«رسائل» عديدة موجهة إلى قيادة حركة فتح خصوصاً والجبهة الشعبية يحذرهم من إضاعة قضيتهم المقدسة عبر انخراطهم في صراعات الأنظمة العربية.
وبرغم أن صداقة وثيقة قد جمعته إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما إلى قائد الجبهة الشعبية المتحدرة من صلب حركة القوميين العرب الدكتور جورج حبش والعديد من القياديين في «الثورة» فقد كان دائم التحذير من التورط في الصراعات العربية الداخلية، أو الانزلاق إلى تأييد طرف ضد طرف أو أطراف أخرى في هذه الدولة العربية أو تلك.
وبين أشهر مقالاته (غير الموقّعة طبعاً) والتي كانت أشبه بنداء تحذير مقال حمل عنوان «الثورة ليست فن تدبير المال والرجال والسلاح».
وعشية انفجار الحرب الأهلية في لبنان انطلق منح الصلح يحذر من الانزلاق إلى المستنقع اللبناني بسمومه الطائفية مما سيدمر هذا الوطن الصغير والجميل من دون أن تستفيد من تدميره القضية المقدسة، بل إنها ستتعرض لضرر خطير يؤثر على مسيرتها ويحرفها عن أهداف نضالها ويصيبها بأمراض لبنانية لا شفاء منها.
أخذتنا السياسة بعيداً عن هذا العالِم العلامة بالأنساب كما بالأحوال في مختلف البلاد العربية، والرجل ـ الجامعة لكثرة ما يجتمع في شخصه من مفكرين ودارسين وبحاثة وكتاب زاملهم في الجامعة أو في ملحقها الجامع مطعم فيصل، وقرأوا عليه ما يفكرون بكتابته من قبل أن يكتبوه، أو أطلعوه على مسودات رسائل الدكتوراه ليأمنوا إلى سلامة استنتاجاتهم.
مع الإشارة إلى أن العديد من قادة الحركات السياسية في المشرق العربي خصوصاً، كما في بعض أنحاء أفريقيا العربية، كانوا من خريجي هذه الجامعة الأميركية، قوميين عرباً أو بعثيين... وهم عادوا منها فشغلوا في بلادهم أحد موقعين: إما مشاركة في السلطة بأفكارهم قبل أن تفتك بها السلطة أو في المعارضة قبل أن يستدرجهم الحكم إلى مواقع «الشريك الرمزي» أو «المبرّر» أو «مفتي الأحكام المغلوطة» بحجة حماية الاستقرار... إلا من جذبته الثورة في فلسطين ومن أجلها فانضوى في فتح أو في الجبهة الشعبية، مقاتلاً يرسم الشهادة أو وزيراً متقاعداً من الثورة.
كتب منح الصلح مجلدات في السياسة ينقصها اسمه.
ولقد كتب أحياناً مرتين ومن زاويتين مختلفتين.. وعلى سبيل المثال فهو قد كتب في «السفير» مجموعة مقالات عن «المارونية السياسية» بوصفها النموذج الكامل للانعزال، ثم رد على طرحه هذا بسلسلة مقالات في مجلة «الحوادث» يوسع دائرة النقاش بالرد على ما كتبه.
منح الصلح المتعدد: المثقف الكبير، الكاتب صاحب الأسلوب المميز حتى ليمكن اعتباره «مدرسة» في الكتابة، يمكنك أن تعرفه منذ السطور الأولى لأية مقالة غير موقعة..
ومنح الصلح صاحب الحضور الباهر، بالنكتة الحاضرة، والفكرة المشعة والأسلوب المميز، «ظاهرة» يصعب أن تتكرر.
لقد كتب مجلدات بلا توقيع،
وابتدع أو استولد عشرات من الكتاب والصحافيين من دون تبنٍ،
وأطلق مجموعة من الشعارات الدالة سياسياً، في لبنان كما في العديد من الأقطار العربية، حملت بصمته وإن لم «يعترف» بشرعية نسبها.
ومن الصعب استذكار منح الصلح من دون استحضار الدكتور كلوفيس مقصود، وقد شكّلا ـ لفترة ـ ثنائياً طريفاً وجميلاً في ابتداع التشنيعات والتوصيفات و«الألقاب».
منح الصلح: علامة فارقة في الزمن الجميل... ومن الطبيعي أن يدخل إلى بيت الصمت في هذا الزمن الذي تلتهمه التشوهات وكل ما يناقض الآمال العراض التي ملأت الدنيا بهجة وأملاً قبل أن تلتهم الأخطاء وسوء التقدير والجهل بالعدو وبالذات أيضاً بشائر التقدم نحو أهداف النضال اليتيم.
GMT 10:13 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
خمسون عاما على رحيلها.. رامى وأم كلثوم.. قصة حب أم عبقرية إبداع؟!GMT 08:46 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
في ذكرى صاحب المزرعةGMT 08:44 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
كيف ستكون علاقتنا مع ترمب؟GMT 08:44 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
بين التسلط بالامتداد أو التسلط والانفرادGMT 08:42 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
مناخر الفضول وحصائد «فيسبوك»GMT 08:41 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
كيف تفكر النسخة الجديدة من ترمب؟GMT 08:40 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
ترمب والداء الأوروبي الغربيGMT 08:39 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
لبنان... امتحان التشكيلمحمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأحلام تطلق ألبومها الجديد "العناق الأخير" وتعرض مفاجآت تعكس عصارة 30 عامًا من الإبداع الفني
أبوظبي - العرب اليوم
الفنانة أحلام أفرجت أخيراً عن أغاني ألبومها الجديد "العناق الأخير"، وذلك بعد فترة من الترويج للألبوم وبعد فترة من تشويق الجمهور إليه، وكشفت الفنانة أحلام عن مفاجآت غير متوقعة في ألبومها الجديد والذي تفتتح به �...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©