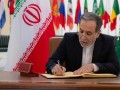الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الأسلوب الإسرائيلي
الأسلوب الإسرائيلي

بقلم - مصطفي الفقي
ظهرت الحركة الدبلوماسية لوزارة الخارجية فى خريف ١٩٧١ وتضمنت نقلى نائبًا للقنصل المصرى فى لندن، ولقد سعدت بذلك رغم علمى بمشقة العمل القنصلى، لكننى رأيت أن وجودى فى لندن سوف يكون فرصة لاستكمال دراستى للدكتوراة، خصوصًا أننى كنت قد سجلت فى جامعة القاهرة لدرجة الماجستير بإشراف الراحل الدكتور إبراهيم صقر فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وعندما هبطت بى الطائرة - أنا وزوجتى - فى العاصمة البريطانية كنت ألتهم الأماكن والمشاهد والشوارع والميادين فى نقلة نوعية كبرى فى حياة ذلك القادم من مصر بعد رحيل الرئيس عبدالناصر بعدة شهور، ولم تكن أول مرة أركب فيها الطائرة فقد كانت الأولى هى رحلتى فور تخرجى عام ١٩٦٦ ممثلًا للشباب المصرى فى احتفالات الجزائر بعيد الاستقلال ونقل رفات الأمير عبد القادر الجزائرى من سوريا إلى وطنه فى الجزائر، كما أنه كان قد جرى تكليفى للقيام بمهمة حامل حقيبة إلى دول شرق إفريقيا، حيث زرت السودان وإثيوبيا والصومال وكينيا وتنزانيا وغيرها من الدول الإفريقية التى كان لمصر رصيد كبير فيها من سياسات العصر الناصرى التحررية والتنموية، وأتذكر أنه أثناء رحلة الطائرة ما بين نيروبى ودار السلام أن جاءتنى المضيفة وهى تحمل طبقًا صغيرًا عليه تفاحة قائلة لى: هذه تحية من الراكب معنا سكرتير أول السفارة الإسرائيلية فى نيروبى، فارتبكت ارتباكًا شديدًا لأن التعامل مع إسرائيلى فى ذلك الوقت كان يعد خيانة عظمى، لذلك تمنيت لو أن هناك نافذة لأقفز من الطائرة وتمتمت بعبارة الشكر للمضيفة وانزويت فى مكانى قلقًا مما حدث لأننى لم أكن أدرك أن الأسلوب الإسرائيلى وقتها كان يعتمد على اختلاق الأحاديث المشتركة أو افتعال محادثات مباشرة مع أبناء الدول العربية، وقد كان التفاح فاكهة ثمينة نادرة فى مصر فى ذلك الوقت قبل حدوث الطفرة الكبرى فى إنتاج الفواكه فى مصر على يد الراحل د. يوسف والى، أستاذ البساتين ووزير الزراعة الأشهر فى الدولة المصرية. أقول ذلك وأنا أتذكر الآن واقعة هزت كيانى بشدة حيث كنت أجلس فى مكتبى بمبنى القنصلية المصرية فى لندن.
وقد كان قصرًا رائعًا فى شارع مغلق تسكنه الأميرة مارجريت، أخت الملكة، ثم الأمير تشارلز، ولى العهد لفترة معينة، وكان لعدد من الملوك والرؤساء فى عصرنا قصور فى ذلك الشارع المميز الذى يقف على طرفيه حرس ملكى بريطانى وكان مبنى القنصلية المصرية يحمل رقم ١٩ فى ذلك الشارع ويبدو كالأيقونة لأنه كان مملوكًا للجمهورية السورية قبل الوحدة ثم دخل فى مقاصة المبانى بعد الانفصال فآل إلى جمهورية مصر العربية حتى انتهت فترة تخصيصه فاشتراه سلطان بروناى وانتقلت القنصلية المصرية إلى موقع آخر بعد ذلك بسنوات، وبينما كنت أجلس فى مكتبى بمبنى القنصلية عام ١٩٧١ حيث كان يضم عشرات بل مئات من المصريين والأجانب لإتمام المحررات القنصلية المختلفة أو الحصول على تأشيرة دخول لمصر دخل فى زحام المواطنين شاب يبدو أوروبيًا وفى الغالب إنجليزى اللهجة وقال لى: إننى ممثل اتحاد الطلاب فى جامعتى ونريد أن نقيم حوارًا مع اتحاد طلاب المصريين فى لندن فهل تتكرم على باسم الشخص الذى أقابله والمكان الذى يوجد فيه؟ وبعفوية شاب فى العشرينيات من العمر سحبت ورقة كتبت فيها عنوان المكتب الثقافى رقم ٤ شارع شيستر فيلد جاردنز غرب لندن (1)، وقلت له: هذا هو المكتب الثقافى وتستطيع أن تذهب هناك وتسأل عمن يمكن أن يساعدك فى ذلك، وجدير بالذكر أن مبنى المكتب الثقافى فى لندن كان ولايزال قصرًا رائعًا مملوكًا للدولة المصرية قضى فيه الأمير فاروق بضعة شهور قبل عودته من لندن إثر وفاة والده الملك فؤاد، وكان يشرف على ولى العهد آنذاك شخصيتان مهمتان فى تاريخ مصر الحديث هما عزيز المصرى، مفتش الجيش ورائد ولى العهد المصرى، وكان معروفًا بالصرامة فى التربية، بينما زميله أحمد حسنين باشا الذى أصبح رئيسًا للديوان الملكى يتولى الجانب الاجتماعى والثقافى فى شخصية ملك مصر القادم، لقد طافت كل هذه المعانى فى ذهنى وأنا أعطى الشاب الذى تقدم إلى مكتبى طالبًا الحوار مع اتحاد الطلاب المصريين فى لندن، وفوجئت فى صباح اليوم التالى بصحيفة الجويش كرونيكال بخبر يتصدر الصفحة الرئيسية بعنوان السيد مصطفى محمد الفقى - ولم أكن كنت قد حصلت على الدكتوراة - يساعد فى إقامة حوار مشترك بين اتحاد طلاب المصريين واتحاد طلاب إسرائيل فى المملكة المتحدة.. وأن ذلك الدبلوماسى الشاب يشغل منصب نائب القنصل وهو الذى أوضح عنوان مقر اتحاد الطلاب المصريين حتى يتم الحوار بين الطرفين، وأصابنى ما يشبه الدوار، فقد اكتشفت أن من جاء إلى مكتبى لم يكن إلا رئيس اتحاد الطلاب الإسرائيليين فى لندن ولم يكشف عن شخصيته وقام بعملية تغيير للحقائق بعد أن أخفى جنسيته وهدفه تحت ستار مهمة طلابية بريئة، وقامت الدنيا ولم تقعد فقد كان ذلك أمرًا مرفوضًا تمامًا فى ذلك الوقت ولم يخطر على بالى أننى وقعت فريسة لذلك الخبر الزائف الذى يروج لنوع من التطبيع بين مصر وإسرائيل، وذهبت إلى مكتب السفير الراحل كمال رفعت وشرحت له ما جرى وتم الإبراق للقاهرة بالواقعة وملابساتها، ويومها أدركت عن يقين أن الأساليب الإسرائيلية لها طابع خاص قد يصعب اكتشافه، وكلما سمعت بيانات الجرائم الإسرائيلية فى غزة وتزييف الحقائق على لسان المسؤولين فيها تذكرت تلك الواقعة وآمنت بضرورة التأكد من نوايا كل من أتحدث إليه خصوصًا على المسرح السياسى!.
GMT 13:05 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
حزب الله بخيرGMT 11:57 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مرحلة دفاع «الدويلة اللبنانيّة» عن «دولة حزب الله»GMT 11:55 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
هل هذا كل ما يملكه حزب الله ؟؟؟!GMT 20:31 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
عشر سنوات على الكيان الحوثي - الإيراني في اليمنGMT 20:13 2024 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
صدمات انتخابيةبورصة المغرب مرشحة لبلوغ قيمة سوقية تريليون درهم هذا العام
الدار البيضاء ـ العرب اليوم
تتجه بورصة الدار البيضاء في المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة ا�...المزيدصابرين تكشف أسرار رحلتها الفنية من الغناء إلى التمثيل وتأثير الكبار في تشكيل ملامح مشوارها
القاهرة - العرب اليوم
خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير ضمن سهرة خاصة عُرضت على قناة CBC بمناسبة أعياد "شمّ النسيم"، فتحت الفنانة صابرين قلبها للجمهور، كاشفةً عن أسرار جديدة في مشوارها الفني، وتجاربها الإنسانية، وندمها الوحيد، وت...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه �...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©